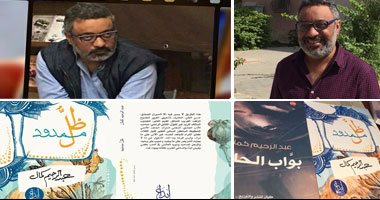أن تعيش لتحكى ...هى السيرة الذاتية الملهمة...و جودة الحكى المفعم بالغرائبية الساخرة. من فرط الإلهام يتولد إحساس الاندهاش وإقناعية التصديق.. كانت الأم تمسك بطرفى الحكى فى المفتتح . وبرأيه إن هناك كلمات لا يحتويها القاموس، لأن الناس جميعًا تعرف معناها.. وبما أن الحنين يمحو الذكريات السيئة ويرفع من قيمة الذكريات الطيبة، فإن فعل التذكر لا يأتى عمدًا ، لكنه يأتى من شفافية الروح، وخيالها الجامح المتوهج.. هذا التوهج الذى يبعث دفأه فى عوالم الروح، وصناعة الحكى، إنها الخبرة الطويلة فى الكتابة الاستشفافية غير المرقمة، ولعبة الاستشفاف هذه مشفوعة بالشفافية الغائرة فى جوهر الروح، والتناجى الحي مع رغبات النفس السحيقة..
هذه السنوات المختزلة التى وظفت تيار الوعى إطارًا ثابتًا للخروج والعودة المحكمة.. حيث استدعاء المشاعر والذكريات المضفرة بالواقعية السحرية ،الغنية بالرؤى والأحلام والكوابيس والخرافات، والمأثورات الشعبية العجيبة، تضفيرًا وتعشيقًا لأحداث فنتازية ناجحة فى احتفافها بالواقع المناظر!
الحكى- إذن- عن رواية المجنونة أو كان يسكن هنا ثم طار.. أو بيضتان فى حلقى.. وهو العنوان المحبب لدى صاحب الرواية ، والذى ينطقه ساخرًا فى حياء.. والرؤية تقتضى أن نحدد تيار ما بعد الحداثة وصفا لهذه الرواية التى كتبها عبد الرحيم كمال على رأس الألفى سنة الماضية. أى إنها صدرت عام 2001 ضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، صدورًا أعقبه إطباق متعمد عن جوهر حكيها وسلامة بنائها الدرامى ، فهى ليست مشغولة بسرد حكاية واقعية، ذات بناء درامى وشخصيات تنمو وتتصارع ، من خلال حبكة تؤدى إلى نهاية منطقية ، مؤسسة على مقدمات فى السياق الدرامى، إنها مؤسسة على تشكيلات متعددة من التداخلات السردية القديمة والحديثة.. فى صورة إشباعية دالة على هصم صاحبها لإجراءات الفن الروائى حكيا وبناء..
والحق لا تعتبر هذه القراءة النقدية الأولى لرواية المجنونة، فقد سبقتها قراءات أخرى تشبعت بالاستيحاء من عمل أولى لكاتب جنوبى سكن فى مصر القديمة ، وطاف مداخلها ،وخبر المجهول من عوالمها المتناثرة ..داخل الحكى السردى للرواية.. ضريح سليمان باشا الفرنساوى ، وأحاء مصر القديمة والتى الذى حدد جموح الخيال.. عندما نظر الكاتب من نافذة شقته ، وطار مع خيط أبيض يلفه قوس قزح ليصل إلى حدود العالم .. رحلة فض فيها كناشة حكيه.. الذى لم يبدأ بعد.. وهو يخاطب صديقه الأبدى الموصوف بالصديق النموذجى حتى القتل.. حيث الارتكاز الثابت فى التجربة الروائية الاندهاشية، المشبع لدائرة الأفكار المتصارعة، الباتر لفيضان الهواجس القاتلة المجنونة.. عندما يطارحه.. فيصمته.. منذ اللحظات المباغتة الأولى لما هو داخلى وحميم ، وكشف للمستور دون جرح أو استفزاز ،وعبر تلصص على الدواخل فى آلية لا تليق بالقراء الطيبين.. إنها ريح الخوف التى تسكنا جميعًا فى نبشنا الأولى.. هذا النبش المبتعد عن جمود الراوى وسطوته القاهرة المضللة أو المنفرة، لتستقر بديلًا عنها الشخصية النافذة إلى صلب الفكر الإنسانى حيث رصد البواطن بصدق.
لقد تطلب ذلك من عبد الرحيم كمال أن يمارس ديكتاتورية حديثه نسبيًّا عندما يحل الراوى الموازى للشخصية كى يقدم بنفسه عالمه الخاص.. عبر عدسة راصدة و مستوى وعى مماثل... إن رحلة البوح هذه أو المصارحة الإبداعية الأولى تستنبت جملة من الشحنات المتكونة ، بدأت بلغة البوح المتحدية والرافضة لسلوك القهر الاجتماعى والتهميش، وفوضى القيم.. ودخول الزائف ليطرد الحقيقى الرصين.. جعل الكاتب نفسه رسول خير، يملك لغة الإنذار ثم هو يرافقها ببناء التبشير الرحيم.. ولا ينسى عند ممارسة هذا الفعل أن يتخذ النبرة المستعلية الرافضة للسلوك الطبقى والطوابق الزاحفة.. نبرة تمدح بقوة وجوده، وتمكنه من أدواته الإبداعية فى عمله الروائى الأول ، والذى توقع له ما عومل به..
وفى تعميق للفكرة الكبرى يحتفى الكاتب بروح الشخصيات الضعيفة المهمشة، والسيدات التى ملأها الوجد.. وخاصمتها الحياة.. والسيدات التى هرستها طاحونة الطبقية ، فنفرت بكلام لا يليق ،وهى تحاكى فعل الضحك والبكاء المستديمين.. والحكاية الإطارية الكبرى المعلقة فى الهواء ، المجنونة التى تطل برأسها من نافذة الطائرة.. لتخاطب العاشق الناظر للخيط الأبيض. الملئ بالأسماء البيضاء ، والممتد فى شوارع القاهرة ، والخارج من حذاء أحدهم ، ولم تكلف السلطات نفسها حتى أن تعلن عن هذا الخبر فى نشراتها الإخبارية التى تأتى على رأس الساعة.. أو حتى هذه الطائرة البيضاء ذات الخطوط الخضراء التى تحمل مسافرا واحدا.
وإزاء هذه الإشكالية الكبرى التى تبدو فنتازية قاهرة - كان على المرء أن ينظر إلى حبيبه كثيرا لأن الذاكرة خوانه - وكان عليه أيضًا أن يلمس حبيبه كثيرًا ،لأن اللمس ينعش الذاكرة.. وعلى المرء أيضًا أن يسكن كهف حبيبه، ولا يخرج منه أبدا .. لأنه ليس للخجولين وجبات ساخنة كما أخبرته المجنونة التى حلم بها يومًا.. فضحكت عليه ، واقتنصت صاحبه إلى كندا ، ثم هو يمازحه بفعل أكثر إضحاكا وإقناعًا عندما يخاطبه فى نهاية الرحلة.. إلى جوار قبر سليمان باشا الفرنساوى حيث المثوى الأخير.
إنها حكاية أحداثها فى السماء ...والأرض تنظر إليها بشغف اللقاء.. وإذا كان للتذكر فائدة ، وهي لعبة تبدو قصدية في بعض الأمور ، فإن قصدية طرح هذه الرؤية النقدية الجديدة جاءت من خلال تناسى البعض أن لهذا الكاتب مشروعا فكريا يتوخاه ، يرصده ويبدع تجاربه من خلاله ، تدعيما وكشفا ،وفي سياق هذا المشروع تأتي هذه الرواية التي لا يعلم عنها البعض إلا القليل ، لتكتمل القراءة النقدية لهذا الكاتب من خلال أعماله ، وهذا من واجبات النقد الجيد .
لا ينسى الكاتب فى النهاية أن يردد مقولة ماركيز الخالدة ، إن الحنين يمحو دائمًا الذكريات السيئة ، ويرفع من الذكريات الطيبة ، لذلك فإنه لم ينج أحد من أضراره.. لكن ضرره أن تعيش بباقة الحب التى زرعها فيك أصحاب القلوب الراحلة ..سيدى همام لك الحب...السيد الشريف الذى أهدى له الكاتب روايته الأولى ...رحمه الله .
حمدى النورج مدرس النقد وتحليل الخطاب.. أكاديمية الفنون بالقاهرة