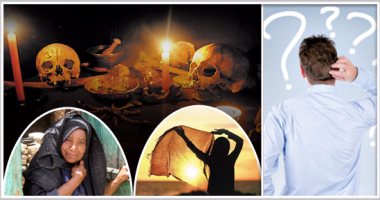نقلا عن العدد اليومى
- بدأ مع الهجرة للعمل بالخليج فى السبعينيات حتى بث فيه الدعاة الجدد روح «الإسبانش» و«المزركش»
فى كل مجتمع تنشأ تلك النوعية من الأسئلة، التى يتداولها الناس همسًا، تصير مادة للنميمة، ولتناقل الشائعات والأخبار فى جلسات المقاهى، وفى ساحات البيوت.. الأسئلة الحرام التى لا يحب أحد أن يجيب عنها، رغم أن الجميع يعرف إجاباتها بالفعل، ولكن إمعانًا فى إضفاء المزيد من الإثارة ونسج الأساطير حولها، تستمر هكذا أسئلة دون إجابات، كثمار معلقة فى الهواء، يراها المارة الجائعون ولا يتجرأون على الاقتراب منها.
فى هذا الملف طرحنا عينة من تلك الأسئلة الحرام، وحاولنا المواجهة بالإجابة عنها.. قد لا تعجب إجاباتنا هؤلاء الذين يستلذون بتركها عارية فى الهواء دون إجابات، وهؤلاء الذين لا يحبون طريقة إجابتنا، ولكنها الصدمة، أفضل ما نستطيع أن نقدمه لمن لا يحبون كشف المستور، أو من لا يريدون الفصل فى القضايا المعلقة بغرض المتاجرة بها.. ومن بين ما اخترنا لكم من أسئلة، تلك الأسطورة الرائجة حول السبب الذى جعل البنات تخلع الحجاب فى مصر، وعن المتسبب فى إدخال هذا الإنجليزى «المكسر» فى الحياة اليومية للمصريين، وحقيقة ممارسة السحر فى المساجد والكنائس فى بلادنا.. كلها أسئلة حرام نشارك قراءنا الإجابة عنها لعلنا نصل.
مع سقوط «الإخوان» بدأت الفتيات خلع الحجاب بالتوازى مع ثورة هائلة فى الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى

لقد زالت عنه تلك القداسة، تكسر رويدًا، وتحول من فريضة دينية إلى واجب اجتماعى، حتى بدأ فى السقوط، حين لم يعد المجتمع يهتم به.. لفظته بعض الفتيات اللاتى خضن تلك الحروب الصغيرة ضده، ومع بعض التحولات الدرامية والاجتماعية، لم تعد للحجاب قيمته وهيبته التى كانت من قبل لدى هؤلاء.
فى السبعينيات من القرن الماضى، وبينما كانت الدولة منشغلة بحروبها مع الجماعات الإسلامية، كانت أجيال من المهاجرين المصريين تغزو بلاد النفط، تذهب فلا تعود مثلما راحت، الدولار يغير الأفكار كما يغير الجيوب، يدفع بالطبقات الدنيا من المجتمع إلى الشرائح الأعلى فيه، كل ذلك يحدث بالتوازى مع عصر الانفتاح الاقتصادى الذى قال عنه السادات «اللى مش هيعمل فلوس اليومين دول مش هيغنى أبدًا».. تحولات اجتماعية كبيرة تؤثر على الموقف من الدين ومن الحياة بشكل عام.
فى بلاد النفط، صحراء وقبيلة تفرض أفكارها وسطوتها على الجميع، النساء تنتقب أو ترتدى العباءة السوداء الفضفاضة وحجابًا صغيرًا على أقل تقدير، رجال يرتدون جلابيب بيضاء، ومصريون يتطلعون إلى هذا وتلك، يحاكون طريقتهم فى الحياة كما التفكير، فيدخل الحجاب مجتمعنا رويدًا مع عودة أول موجة من المهاجرين، وقبل أن يعودوا فإن عاد زوج فى إجازته الصيفية فرض الحجاب على زوجته، وذهب ليجمع ما استطاع من دولارات، وهكذا، حتى إذا جاء عصر التسعينيات، كان الحجاب قد كسا رؤوس الطبقة الوسطى إلا قليلًا، وصارت من لا ترتديه نشازًا عن القاعدة.
فى تلك الأثناء يكبر جيل السبعينيات والثمانينيات، يدخلون سنوات المراهقة فى عصر التسعينيات الفاتر، العالم مشغول بالجينز وبالموسيقى الغربية، أشرطة الفيديو والكاسيت تغزو السوق، أمريكا صارت هنا، والعولمة تبدأ أولى موجاتها الكاسحة، فى نهاية العصر يتغير شكل الدعاة، يخلعون عماماتهم ويرتدون البدل الغربية، والجينز، شباب ليسوا من خريجى الأزهر لا يشبهون الدعاة التقليديين، بل هم متحررون من كل ذلك، يهبطون علينا بخطاب شبابى ودعوة دينية «كاجوال» تتسم بالسطحية، وتفتقر إلى علم المعممين، لكنها فى الوقت نفسه تعرف أهدافها بدقة، دعاة تربوا فى مدارس الإخوان ومساجدهم التى احتلوها ليواجهوا الشيوعيين فى عصر السادات ولم يتركوها بعده، دعاة يعرفون جمهورهم بدقة، جيوش من المراهقين والمراهقات، يجذبهم المظهر ولا يعيرون الجوهر اهتمامًا كبيرًا، شباب فتح عينيه على الوجبات السريعة، وسينما المقاولات، جيل «محشور» بين زمنين، فلا هو ابن لحقبة الستينيات ذات الأفكار الأيديولوجية العميقة، ولا هو ابن للثورة المعلوماتية، هو جيل أخذ شيئًا من كل شىء، وكان الدعاة الجدد من ضمن ما أخذ.
«أطباق الدش» تظهر فوق أسطح العمارات، تأتى من الخليج فى البداية، ثم تتاح فى مصر، والفضائيات تغزو المشهد، للدعاة نصيب فيها، بعدما ربوا جمهورهم فى النوادى الرياضية والاجتماعية والمساجد، عمرو خالد داعية نادى الصيد أول المنضمين إلى سرب «الدعاة الكاجوال»، بصوته الرفيع وخطابه السطحى يجتذب الشباب، يحوطونه فى الاستديو كنجم يستمع له الجمهور فى مسرح، يهاجمه الدعاة التقليديون، ويتهمونه بنقص العلم وقلة الدين، فيحصل على الدكتوراة من الأزهر بعدما كان دارسًا للتجارة، ولا يتوقف أبدًا عن دعوته.
«الحجاب» من موضوعاته الأساسية، حتى إنه ينتج شريط كاسيت يحث فيه الفتيات على ارتدائه، فيكتسح السوق، وتبدأ المراهقات فى ارتدائه أملًا فى الجنة وخوفًا من النار، عمرو خالد يعرف طريقه جيدًا، لا يقسو على الفتيات، فلا يحرم الحجاب الذى أطلقن عليه «إسبانى»، ولا يمنعهن من ارتداء الملابس الكاجوال التى يحببنها، يكتفى بغطاء للرأس، يصفها بالخطوة المؤدية للحجاب الكامل، تلك الخطوة التى لا تأتى غالبًا.
مصطفى حسنى يلحق بأستاذه عمرو خالد فى سوق الدعاة، شاب أنيق بملابس كاجوال وعضلات مفتولة، ووجه وسيم، يصير نجم شباك الفتيات، ونموذجًا لكل شاب، وهكذا من داعية إلى آخر يزدحم السوق، والحجاب ينتشر ويتوغل، ثم يدخل الموضة بعنف، بيوت أزياء للمحجبات تظهر، مصانع تكمل ما تعرى من ملابسهن ليتماشين مع الموضة «البدى الكارينا» مثلًا، الحل السحرى لأى عرى فى الملابس، يكسوه بأناقة وحشمة.
الحجاب يجد سوقًا رائجة، ينتبه صناع الصحف، فتظهر مجلة «حجاب فاشون»، ربطات جديدة، وملابس للفتيات، يواجهن ملل المظهر بتغييره، ثم يدخل عصر الفيديو كليب.
عام 2008 ظهر مطرب شاب يسمى حسام حجاج فى أغنية جديدة بعنوان «اتحجبتى برافو عليك»، وأظهر الكليب المطرب فى دور الخاطب الذى فوجئ بارتداء خطيبته الحجاب، فور عودته من السفر، فانهال عليها بالهدايا والإيشاربات، وهو يردد «أيوه كدا ربنا يهديكى، حجابك أجمل حاجة موجودة فيكى، أجمل هدية من عند الله».
الأغنية التى لاقت رواجًا كبيرًا آنذاك، حين ظهرت بالتوازى مع تنامى دور الدعاة الجدد، ونشاط عمرو خالد ورواج أشرطته حول الحجاب، صارت بعد ذلك وسيلة يستخدمها الرجال لدفع زوجاتهم أو حبيباتهم نحو ارتدائه.
وأظهر الكليب صورًا تليفزيونية ولقطات لمحجبات يعانين بعد ظاهرة منع الحجاب فى فرنسا، وهى نفس الفكرة التى استند إليها كليب آخر لحسين الجسمى، ظهرت فيه محجبة تواجه صعوبة فى إيجاد عمل بسبب تمسكها بحجابها، بعد قرار الحظر القانونى لأى شكل من أشكال التمييز الدينى فى فرنسا، الدولة التى تتمسك بعلمانيتها.
وخرج علينا مغنٍ آخر يسمى هيثم سعيد، بأغنية أخرى بعنوان «هما مالهم بينا يا ليل»، ورغم ابتعاد موضوع الأغنية عن الحجاب كمفهوم دينى، فإنه ظهر بصحبة «موديل» محجبة لأول مرة، يتراقص معها على كوبرى قصر النيل ليلًا، بينما تلاحقه نظرات المارة والعابرين، وهو يتساءل: «ليه شاغلهم شوقنا اللى واخدنا يحسدونا وماله ياليل اللى غيران منا يقلدنا»، ما أكد أن الحجاب صار ضمن ملابس الفتاة المصرية، ولا بد من التعامل مع المحجبة تمامًا كغير المحجبة دون أى تمييز.
يفقد الحجاب قداسته تدريجيًا، تبقى عليه الفتيات مع ملابس أضيق بعض الشىء، بنطلونات جينز وبلوزات عصرية، ثم واكب ذلك تطور فى شكل الحجاب نفسه، فظهر ما أطلق عليه «الحجاب الإسبانى» الذى عادة ما يكشف العنق، ثم ظهر «التيربون» وهو مجرد بونيه يغطى الشعر ويكشف الرقبة أيضًا، مع الإبقاء على شكل الحجاب التقليدى، ولكن مع ملابس تصف وتكشف أكثر مما تغطى، كما عملت الفتيات أيضًا على إخراج خصلات من شعورهن وصلت أحيانًا إلى كشف نصف الشعر تقريبًا.
تأتى ثورة يناير 2011، زلزال يهز الأفق، الفتيات فى كتف الرجال، لهن ما لهم، وعليهن ما عليهم، نحن فى الثورة شركاء، الثورة تنتكس، ولكن الفتيات يربحن مكاسب اجتماعية، يتمردن على الحجاب، يتراجع تأثير الدعاة الجدد حتى أن موقع عمرو خالد نفسه يواجه أسئلة مريديه حول خلع الحجاب.
فى بداية الموجة، كان الأمر مستنكرًا، تصبح خالعة الحجاب مادة للنميمة والسخرية والنصيحة أحيانًا، ثم يعتاد الناس، الأمر لم يصبح حدثًا يستحق التوقف عنده.
الهزة الثانية تأتى، الإخوان يعتلون سدة الحكم، يحصدون أغلبية البرلمان بغرفتيه، الشورى والشعب، يشكلون الوزارات، يهددون فى الإعلام، الدولة الدينية ستأتى، الخوف يعم الجميع، صورة المتدينين تهتز فى خيال العامة، الإخوان يقولون ما لا يفعلون، وعدوا بالمشاركة لا المغالبة فانقضوا على الحكم، قالوا سنشرك الجميع فى تجربتنا، فأقصوا كل من لا يتبعهم، التجربة تغير المجتمع، والناس تضج بالمظهر والخطابات العاطفية، يعلو صوت العقل، والحجاب يبدأ فى الانكسار مرة أخرى، البنات تواصل التخلص منه.
الجماهير تزحف فى الشوارع تندد بحكم الإخوان، المجتمع يلفظ الإسلام الشكلى، والجيش يقصيهم عن الحكم، الفتيات تخلع الحجاب أكثر، كل هذا بالتوازى مع ثورة هائلة فى الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى، وإمكانات أكثر فى الصورة والتقنية، الرغبة فى الجمال تنتصر، الشعور تظهر فى الشوارع، الحجاب يخفت قليلًا ولا يختفى، لكنه يواجه مقاومة وتمردًا لدى أجيال أصغر لم تدخل دوامة التسعينيات وما تلاها من تحولات، أجيال نشأت فى عصر المعلومات، فلن يرهبها أحد كان يحتكر المعرفة لنفسه، ولن يُرغبها آخر بخطاب عاطفى خفيف.
الدراما التليفزيونية ترى فى قوة وصلابة وتتعامى عن قهرهن

ترسخ الدراما التليفزيونية صورة واحدة للمرأة الصعيدية، فهى سيدة قوية مسيطرة، تسعى للثأر، وتدفع أبناءها إليه دفعًا، تتحكم فى الأسرة كاملة، ولا يستطيع أبناؤها كسر كلمتها، كفاطمة تعلبة فى مسلسل «الوتد»، وهى صورة قد تختلف كثيرًا عن واقع المرأة الصعيدية الذى لا تراه الدراما.
المرأة فى الصعيد صبورة، حمول، تفعل كثيرًا وتتكلم أقل، تتسم بذكورية ورثتها عن جداتها، فالنساء أقل شأنًا من الرجال، ما فى ذلك شك، ليس لامرأة فضل على رجل ولا بالعلم ولا بالدين، تبقى النساء هناك نساءً والرجال رجالًا.
تكتسب الأم سطوتها من إنجابها الذكور.. وكلما زاد العدد ارتفعت مكانتها
المجتمع فى الصعيد شديد التحفظ يدافع عن تقاليده بشراسة، حتى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين مجتمع الصعيد فى مطلع القرن العشرين ومجتمع الصعيد المعاصر، ولا تكتسب المرأة قيمتها ولا تعلو كلمتها إلا حين تصير جدة، ولكن ليس كل الجدات كذلك، فالجدة ذات الشخصية القوية هى فقط من تستطيع أن تفرض سطوتها، وتسترد ما أخذ منها فى شبابها، تستعيد كل رغباتها فى قول رأيها أو الاستماع إليه، بل وتحاول فرضه بالقوة بعد سنوات من الصمت.
كنت فى السابعة من عمرى، حين سمعت جدة ريفية فى إحدى قرى أسيوط تأمر حفيدتها بالوقوف، لأن أخاها الأصغر قد حضر إلى البيت، وحين اعترضت الفتاة التى كانت طالبة فى الثانوية العامة، فائقة فى دراستها، بينما فشل أخوها فى الحصول على الشهادة الإعدادية، قالت لها الجدة: «تقفى عشان هو واد وأحسن منك»، هكذا ببساطة الأمر لا يحتاج إلى تفسير.
أما الأمهات فيكتسبن أهميتهن فى المجتمع من إنجاب الذكور، فأم الذكور تتمتع بمكانة أكبر فى المجتمع والعائلة الكبيرة من أم البنات، والتى لديها ذكر واحد ليست كالتى لديها اثنان أو ثلاثة، لذلك فإن نساء الصعيد يتسابقن للفوز بالمولود الذكر الذى يضمن لهن مكانة اجتماعية أرفع، بل ويضمن الاحتفاظ بالزوج وعدم التفكير فى زواج ثانٍ، وهو الأمر الذى لا يختلف عليه المتعلمون والأميون هناك.. أعرف أستاذًا جامعيًا متزوجًا من زميلته الأستاذة بكلية الطب، أنجب منها أربعة فتيات، وقررت التوقف عن الإنجاب من أجل التفرغ لأبحاثها ومستقبلها العلمى، وكذا مستقبل بناتها، فما كان منه إلا أن تزوج عليها لينجب الذكر، وقد كان له ما أراد.
فى عائلتنا من أنجبت أربعة ذكور، ومن أنجبت أربع فتيات، وبالطبع تتمتع أم الشباب بمكانة كبيرة وتقدير أرفع من الجميع، لأنها استطاعت أن تأتى بكل هذا العدد من الذكور، بينما ظلت أم البنات تحاول الإنجاب حتى أتاها الذكر فى الولادة السادسة، فربته الفتيات الأكبر، ومع مرور الزمن يصبح هذا الذكر الذى يطلق عليه فى المخيلة الشعبية «ديك البرابر» الأكثر حظوة لدى الجميع، وبالطبع تفسد تربيته بعدما يبالغ الجميع فى تدليله لأشياء لا فضل له فيها إلا نوعه.
«الختان» أيضًا لم يختفِ، وإن كان قد قلّ عما مضى.. كان للحملات التى قادتها سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، دور كبير فى ذلك، فانتشر الوعى بين نساء الطبقة المتعلمة، اللاتى كنّ يؤمنّ بالختان كجزء من الشريعة الإسلامية، والتقاليد الحاكمة التى لا يمكن الخروج عليها، بل إن بعض الأطباء قد تسربت إليهم الخشية من إجراء تلك العمليات المحظورة قانونًا بعد تكرار سجن من تسببوا فى موت فتيات، ولكن ماذا عن القابلات؟، ما زالت القابلة حتى اليوم تجرى عمليات الختان فى المنازل بأدوات بدائية دون أى تعقيم أو ضمانة لاشتراطات طبية صالحة، ويجرى الأمر فى طقس فلكلورى، فيتم خداع الطفلة الضحية، وإيهامها أو تخديرها رغمًا عنها.
حين كنت طفلة فى الصعيد، سمعت عن قريبات لنا فى القرى أجرت لهن أمهاتهن تلك العملية القاتلة، الأولى أوهمتها أمها بضرورة إجراء عملية إزالة اللوزتين، واصطحبتها لعيادة جراح فخرجت منه مبتورة الجسد، أما الثانية فمنحتها أمها دواء منومًا وتمكنت القابلة من إجراء العملية الجراحية لها بعدما تم تخديرها عدة مرات حتى لا تصرخ، وقد كان لعملية الختان أثر بالغ على نفسية الفتيات، خاصة وسط سخرية الأهل والجيران منها.. بعد إجراء العملية تحاول الطفلة الضحية الحركة، فتنفرج ساقيها إثر الجرح، وهو ما يعنى بوضوح أن الطفلة قد تعرضت لعملية الختان فتصير أضحوكة القرية حتى تشفى، وقد رأيت هذا المشهد أمامى كثيرًا فى شوارع أسيوط، حين كنت طفلة نجت من تلك العملية القاتلة.
ما يسميه القرآن سحراً يطلق عليه الإنجيل «موهبة إخراج الشياطين»

يسميها الإنجيل «إخراج الأرواح الشريرة»، ويفضل القرآن استخدام لفظة «سحر»، بينما تفضل المخيلة الشعبية تسميتها بالعوالم السفلية والجن والعفاريت.. تتعدد المسميات والأصل واحد، ما يصدقه الناس ويصفه العلم بالخرافة، ما تؤصله كتب الدين، ويراه العلماء تراثًا أو من قبيل الروايات التاريخية قبل التطور الهائل فى العلم، وما توصل إليه الطب النفسى، كل تلك النقاشات تطرح السؤال: هل يمارس رجال الدين السحر فى المساجد والكنائس؟
كما نجوم السينما، يشتهر كهنة بتلك الموهبة كما يسميها الإنجيل، إخراج الجن وطرد الأرواح الشريرة، القمص مكارى يونان، كاهن كنيسة الأزبكية، سيدهم جميعًا، يكتظ اجتماعه الأسبوعى كل جمعة بالكاتدرائية القديمة بمئات المسلمين والأقباط الراغبين فى التحرر من تلك اللعنة، الكاهن الشهير يفعلها على الهواء مباشرة، يقرأ مزامير ويمارس طقوسًا أمام الناس، «اليوتيوب» يمتلئ بفيديوهات للممسوسين الذين يتعافون على يده، مشاهد مرعبة لأصوات غريبة تصدر من داخل الممسوس، حوار يجريه الكاهن مع الجن، الطب النفسى له تفسير آخر، يرى الأطباء أن هذا الصوت ما هو إلا أعراض لخلل فى جهاز الاستقبال لدى المريض تجعله يصدر أصواتًا غير صوته.
وعلى صعيد الأديرة، فإن دير مارجرجس بميت دمسيس بالدقهلية، قد اشتهر بإخراج الجن والشياطين، ففى قبو مظلم، أسفل كنيسة العذراء، وخلف باب خشبى محاط بسياج من شباب الكشافة الكنسية، ترى غرفة المعذورين أو ضحايا الجن والشياطين، تنزل سردابًا صغيرًا، يقابلك سياج خشبى، أمامه طوابير المنتظرين، سيدات محجبات، ورجال ملتحون عجزوا عن إيجاد علاج للجن عند الشيوخ، فقصدوا القساوسة، ومسيحيون آخرون يطلبون خروج المس من أجسادهم.
يؤكد عم ميخائيل الشماس، المتخصص فى إخراج الأرواح الشريرة، أن الإيمان الضعيف يوقع الإنسان فى براثن الأرواح الشريرة، كما أن الدجالين يصعبون من مهمته التى تتراوح كل جلسة منها بين عشر دقائق وربما ست ساعات، يُخرج فيها جنًا أو جيشًا من الشياطين، أو ملكًا عليهم.
الأمر لا يختلف كثيرًا فى المساجد، يحفل موقع الفيديوهات «يوتيوب» بلقطات تسجل إخراج الجن فيها، وأمام جموع المصلين، فالإمام يفتح حوارًا مع الجن، ويسأل الممسوس: هل تقرأ القرآن؟، سأحرقك، ويرد الصوت الداخلى الغريب.
فى الغربية، ومنذ شهور، استطاع إمام مسجد بسمنود أن يقنع سيدة بضرورة إخراج الجن من جسدها، فاقتادها إلى غرفته، وبدأ فى ملامسة جسدها، فما كان منها إلا أن اتهمته بالتحرش الجنسى، حيث يقضى الآن عقوبته فى أحد السجون.
الشيخ محمد الغزالى نفسه خصص كتابًا بعنوان: «علاقة الإنسان بالجان.. الأسطورة التى هوت»، وصف فيه من يؤمنون بتلك الأقاويل بمن يتجاوزون العقل والنقل معًا، يؤمنون بمرويات عديمة القيمة، تصيب الإسلام وتؤذى سمعته.
ويوصى الغزالى: «فلا تفتحوا أبوابًا للخرافات بما تصدقون من مرويات تصل إليكم.. قلت: هناك أمراض نفسية أصبح لها تخصص علمى كبير، وهذا التخصص فرع من تخصصات كثيرة تعالج ما يعترى البشر من علل، ولكنى لاحظت أنكم تذهبون إلى دجالين فى بعض الصوامع والأديرة فيصفون لكم علاجات سقيمة، ويكتبون لكم أوراقًا مليئة بالترهات، فهل هذا دين؟»
فى المسيحية، يصطدم الأمر بقناعات ثابتة لدى الأغلبية، ومرويات سردها الإنجيل عن مريم المجدلية التى أخرج المسيح من جسدها سبعة شياطين، حتى أن الراهب تيموثاؤس المحرقى أصدر كتابًا كاملًا عما اصطلح على تسميته «موهبة إخراج الجن والشياطين».
«الماميز» يعاقبون الأطفال على الكلام بالعربية على الـ«نوتى تشير»

بينما تمارس عاداتك اليومية فى السير فى الشارع، أو تناول الطعام، أو حتى مشاهدة التليفزيون، ستزعجك تلك الإنجليزية المكسرة التى يتحدث بها الناس فى بلد لغته الأولى هى العربية، حتى وإن طغت العامية المصرية وصارت لغة ثانية، وشابها الكثير من المصطلحات الهجينة التى تخلط بين العربية والإنجليزية، ستسمع فعلًا إنجليزيًا وقد سبقه تصريف عربى، فتجد الياء وقد سبقت مصدرًا لفعل إنجليزى، كأن تسمع أحدهم يقول محتاج «يـأكتف» حسابه فى البنك.
فى المدارس مثلًا تفضل الأمهات الجديدات أن يطلق عليهن لقب «الماميز»، وهو جمع كلمة «مامى»، تلك التى كانت ومنذ سنوات مسبّة الطبقى الوسطى لمن يعلوها من طبقات، فإن قابلت فتاة شابًا يلقب أمه بـ«مامى» صار هذا الشاب «الفافى» مادة للضحك بينها وبين زميلاتها من نفس الطبقة، إلا أن انتشار التعليم حتى وإن كان بهذه الرداءة قد صاحبته رغبة فى التغريب الذى تتبدى أولى مظاهره فى استعمال اللغة الإنجليزية، بديلة عن العربية أو مختلطة بها، فلا نعرف لها رأسًا من ساق.
ستشاهد أيضًا من بين «الماميز» من تحرص على تعليم ابنها الصغير الإنجليزية قبل سن الحضانة، دون أن يعرف هذا «التشايلد» مسمى نفس الكلمات باللغة العربية، حتى أن بعض الأمهات تعاقب الأطفال الصغار إن تحدثوا ببعض الكلمات العربية أمام الناس، فاللغة الأصلية صارت شيئًا من الماضى، بل صارت دليلًا على الابتعاد عن متطلبات الطبقة الاجتماعية الجديدة.
الدكتور جلال أمين، المفكر الاقتصادى، صاحب كتاب «ماذا حدث للمصريين؟»، تنبه إلى ذلك مبكرًا حتى إنه خصص فصلًا كاملًا فى كتابه «ماذا حدث للمصريين؟» عن متغيرات المجتمع المصرى وتطوره فى نصف قرن 1945 حتى 1995، حيث رصد خلال كتابه تلك العلاقة الغامضة بين المصريين واللغة العربية وقت صدور الكتاب عام 1999، أى قبل أن نصل لتلك المرحلة التى صار فيها الكلام بالعربية عارًا يلاحق صاحبه.
«كانت اللغة العربية تتمتع بمكانة رفيعة فى مصر منذ نصف قرن، كان لا يزال مما يمكن أن يفخر به المرء فى ذلك العصر أن يكتب بلغة عربية صحيحة، وكان الخطأ فى النحو والإعراب كتابة وإلقاء مما يمكن أن يخجل منه المرء أو يحاول تجنبه»، يقول جلال أمين، «حتى أن معايير الحكم على السياسى أو الوزير كانت قوة وجمال لغته إذا ما ألقى خطبة، وكان مجمع اللغة العربية يضم أئمة الفكر والأدب والعلم فى مصر، ويتمتع بالاحترام الشديد والمهابة، وكان الحصول على عضوية هذا المجمع شرفًا لا يدانيه أى شرف».
ثم ينتقل أمين إلى حالة مضادة تمامًا لكل ما سبق، «ففى السنوات الأخيرة صار الخطأ فى اللغة العربية أمرًا لا يستحى منه المرء، بل أصبح لفت النظر إلى الخطأ وإعطاؤه أى اهتمام هو ما يستحى المرء منه».
يعرج أمين على حال الصحافة والإعلام المصرى وعلاقتهما باللغة العربية، فيقول: «فقد أصبحت كفاءة الصحفى أو فشله لا علاقة لها بمعرفته أو جهله باللغة العربية»، ويسخر من علاقة الوزراء باللغة العربية فيقول: «لم يعد من الجائز مع كثرة مشاغلهم وكثرة تعاملهم مع الأجانب أن تطالبهم بالالتفات لمثل هذه الصغائر، وانقضى ذلك العصر الذى كنا نسمع فيه عن صك مجمع اللغة العربية لفظًا جديدًا كمقابل اللفظ الأجنبى، فلم يعد المجمع قادرًا على ملاحقة هذا التيار الكاسح لغزو المصطلحات الأجنبية والتعبيرات لحياتنا».
الكتابة باللغة العربية حدث لها ما جرى للكلام وربما أسوأ، ففى مطلع الألفينيات ظهرت لغة كتابة جديدة تمامًا تخص العرب وحدهم، ليست عربية ولا إنجليزية ولا فرنسية تجئ من شمال أفريقيا، بل صارت مزيجًا من كل ذلك، «الفرانكو آراب» بدأ كتقليعة بين جيل الشباب حتى صار لغة لحديثهم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، يكتبون العربية بحروف إنجليزية، لينتج لنا كائن مشوه مسخ، يستعيض عن حروف لغة الضاد بالأرقام، ككتابة حرف «ع» بالرقم اللاتينى «3»، وكتابة الهمزة على السطر بالرقم «2»، مع المزج بين الكلمات الإنجليزية بالفعل، وتلك العربية المكتوبة بالحروف اللاتينية، وهو أمر إن كان دليلًا على شىء فهو دليل دامغ على الفشل فى إتقان اللغتين، أو ربما أزمة هوية.. كاتب «الفرانكو» يتمسك بلهجته العامية العربية، ويكتبها بحروف لاتينية، فلا هو مارس تمارينه فى استعمال الإنجليزية، ولا نجح فى إيصال المعنى بالعربية، وسط صعوبات جمة فى قراءة لغة الضاد بحروف غير حروفها، وهى الفريدة فى كل حرف.
يعود ذلك أيضًا إلى انتشار مواقع التواصل الاجتماعى بشكل غير مسبوق، ما دفع الجميع للتعبير فى مساحات لم تكن متاحة من قبل، وهو ما يعبر عنه الفيلسوف الإيطالى الشهير أمبرتو أيكو قائلًا: «إن أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون فى البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأى ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورًا، أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء».
يكشف فيلم «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة» الكوميدى لمحمد هنيدى، الذى عرض فى السينمات للمرة الأولى عام 2008، عن تلك الأزمة، فالبطل مدرس لغة عربية ريفى يتمسك بلغته، ويحاول تعليمها لأولاد الطبقات العليا ممن لا يعيرونها أى اهتمام، فيصير المدرس الأضحوكة، يحاول أن يبيع بضاعة لا تجد من يشتريها، الفيلم أنتج مصطلحات جديدة للسخرية، حتى أنك تستطيع أن تسمع بسهولة سبة «أنت عامل نفسك مدرس لغة عربية» إذا ما حاولت تصحيح اللغة، أو لفت النظر لها.
يشير جلال أمين إلى أن بعض الكتاب المعاصرين يعمدون إلى استخدام الإنجليزية فى مواضع يصح فيها استخدام العربية، إما لوجود بديل معجمى أو لعدم الحاجة لاستخدام الإنجليزية أصلًا، إلا إذا ارتبط الأمر بالرغبة فى إشاعة مصطلح، وهو ما يعبر عنه أمين قائلًا: «لا أستطيع أن أمنع نفسى من الاعتقاد بأن انتشار هذا النوع من السلوك فى الكتابة العربية يكمن وراءه فى الكثير من الأحيان نفسية غير سوية ومعقدة، فالكاتب كثيرًا ما يعرف درجة غموض ما يكتب وتعقيده، بل وكثيرًا ما يعرف طريقًا لتجنبه، ولكنه يسترسل فى الأمر استعذابًا للغموض وتفضيلًا لهذا التعقيد، متظاهرًا أمام القارئ المسكين بأنه عالم كبير، ومستغلًا انتشار الجهل باللغات الأجنبية فى بلادنا، فيستخدم القليل الذى يعرفه منها فى التمويه على الناس الذين وجدهم هذا الكاتب تحت رحمته، سواء كانوا طلبة فى جامعة أو قراء فى صحيفة أو مستمعين فى إذاعة لا يستطيعون استيضاح الأمر منه».
يعزو جلال أمين العلة التى أصابت اللغة العربية فى مجتمعنا إلى الحراك الاجتماعى الذى حدث فى مصر طوال الخمسين سنة الماضية، فقلب التركيب الطبقى للمجتمع المصرى رأسًا على عقب، ومن ثم خلق أنماطًا من السلوك لم تكن معروفة من قبل، ومن بين هذه المواقف، الموقف المؤسف من اللغة العربية، وبعد مرور أكثر من 18 عامًا على صدور كتاب جلال أمين المشار إليه، أن يصبح من بين هذا الجيل آباء وأمهات، يعاقبون أبنائهم على «النوتى تشير» إذا ما تحدثوا العربية، ناهيك عن التفاوت الطبقى الضخم فى التعليم، وما أنتجته المدارس الدولية التى تدرس مناهج أجنبية لطلاب مصريين من عزلة إضافية عن التراث والهوية والمجتمع، خاصة وهى تدرس اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية كمواد غير أساسية، وهو مشروع يضع بذور التخلص من الهوية ويرويها بآلاف الجنيهات سنويًا، طمعًا فى استمرار البقاء فى تلك الطبقة التى تحقق لأبنائها أحلامهم فى الثراء والبقاء فى المجتمع الاستهلاكى.