ننشر مقال للكاتب والشاعر شعبان يوسف عن الناشرة الراحلة راوية عبد العظيم (رحلت يوم 6 مايو 2021) يتحدث فيها عن دور رواية في التحدى للفكر المتطرف عن طريق النشر لمجموعة من التنويريين على رأسهم فرج فودة ونصر حامد أبو زيد
مدخل شخصى:
فى الأسابيع الأخيرة من عام 1992 التقيت بالسيدة راوية عبد العظيم، لأول مرة، وذلك لأسباب فنية محضة، وكانت سيرتها المتناثرة تسبقها من خلال بعض الأصدقاء الذين شاركوا بقسط كبير فى الحركة الوطنية الديمقراطية ذات الطابع الطليعى منذ أوائل عقد السبعينات، مما سنحاول توضيحه لاحقا، وفى الحقيقة ليس لدىّ الكثير من المعلومات الخاصة التى أحاطت بالعزيزة راوية، كما أننا مشغولون بالدور الذى قامت به رواية فى مجال النشر بشكل أساسى، بعيدا عن أحاديث النميمة المعتادة، بالتالى سوف نرصد بعض وقائع الزمن الذى عاشت فيه، وهو زمن يستحق أن يشار إليه دوما، إن لم نستطع روايته بشكل كامل، فعقود السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت فاعلة فى تاريخ بلادنا بشكل لا ينمحى من الذاكرة، وبالتأكيد فهذه العقود قد تركت بصمة لا تزول أبدا، وهى العقود التى شهدت صعودها "راوية" كإحدى المقاتلات فى الحركة الوطنية الديمقراطية، ثم شهدت صعودها الثانى فى مجال النشر، ثم شهدت أفول نجمها الاضطرارى بشكل غامض، أو غير واضح، واختفاء مشاركاتها فى أى فعاليات ثقافية، وكأنها زهدت كل شىء، كما تردد أنها رحلت فى غضون العقدين الأخيرين، وفى الحقيقة كانت راوية تعيش فترة هدوء كاملة وطويلة، وربما هدوء من جرّب كل العواصف، وعليه أن يترك الميدان لغيره، بعد أن ترك علامته الخاصة والمميزة، تلك العلامة التى لا أستطيع - بفضلها - أن أرى دارا ناجحة للنشر فى مصر، إلا ورأيت بصمات دار سينا، وراوية عبد العظيم فيها.
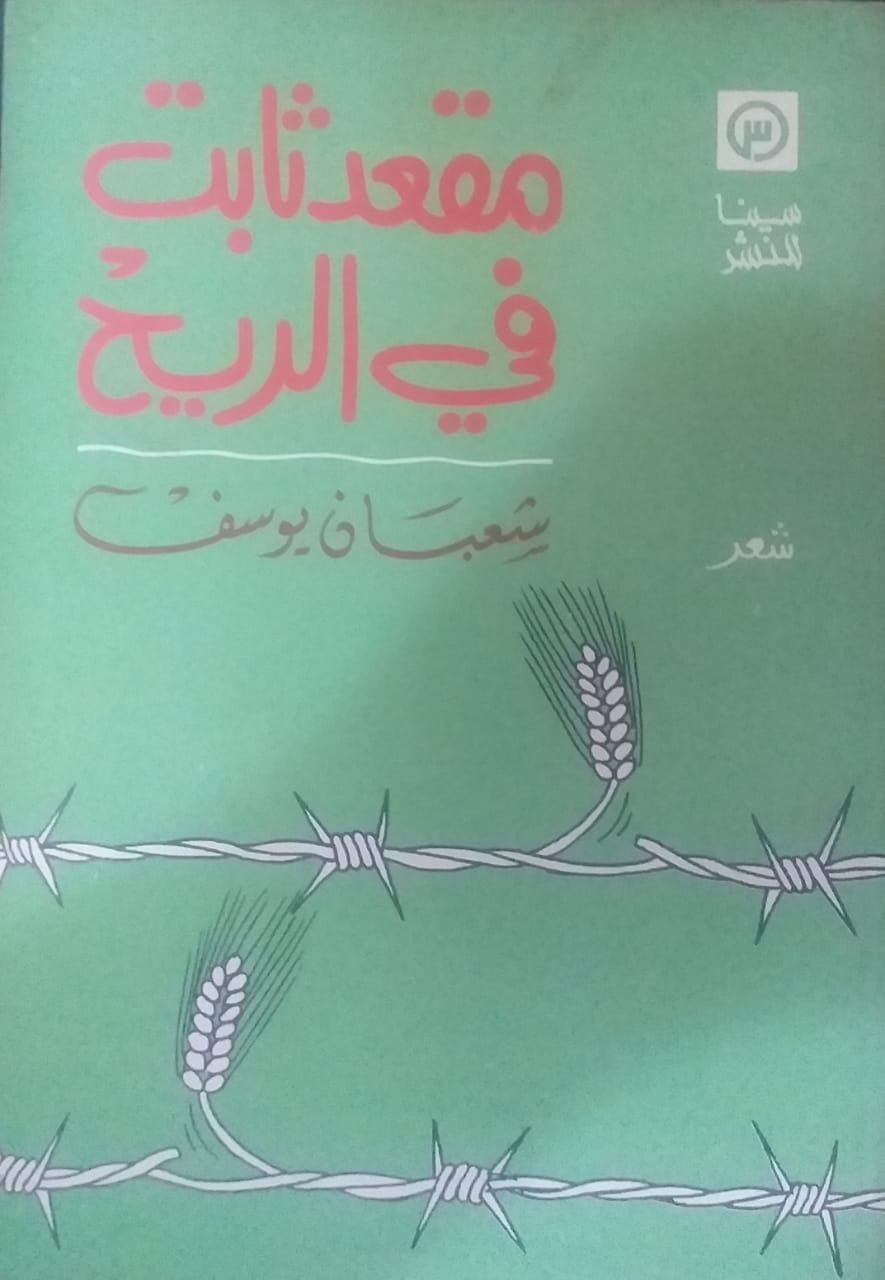 مقعد ثابت فى الريح
مقعد ثابت فى الريح
كان هذا اللقاء الأول فى مقر "دار سينا للنشر" 18 شارع ضريح سعد زغلول، الطابق الثالث بمنطقة المنيرة قصر العينى، ذلك الحى السكنى الذى يتوسط منطقة جاردن سيتى الأرستقراطية، وبالقرب من حى السيدة زينب الشعبى، ودائما ما أشعر بأن ذلك الحى "هجين"، أى أنه يحمل رائحة الحى الشعبى، كما أنه لا يخلو من ارستقراطية ما، وربما وجود ضريح الزعيم سعد زغلول يعطيه كثيرا من الوجاهة.
كان هذا اللقاء مفاجأة كاملة بالنسبة لى، حيث إن صديقتى العزيزة الكاتبة الروائية سلوى بكر كانت قد أخذت منى مخطوطة شعرية لى على سبيل القراءة، وبدون علمى أعطتها للسيدة راوية لكى تنشرها فى ديوان، وكانت المخطوطة التى كتبها الصديق العزيز الروائى فتحى إمبابى على الكمبيوتر - الذى كان حديثا جدا فى ذلك الوقت - واختار لها العنوان: "مقعد ثابت فى الريح"، وهذا العنوان كان لإحدى قصائدى الحديثة آنذاك، قد ضمت - تلك المخطوطة - بضع قصائد من زمن السبعينات، والتى كانت منشورة فى مجلات الماستر آنذاك، وقصيدة أو أكثر من عام 1992، كان هذا يحدث دون معرفة منى أوتبييت أى نيّة للنشر، لذلك كانت مكالمة سلوى بكر، وإبلاغى بالذهاب لمراجعة الديوان مفاجأة لى، وأبديت لها استغرابى الكامل لذلك التصرف، وقلت لها بأننى لم أكن مستعدا لذلك، لكنها قالت لى: استغراب إيه، واستعداد إيه! وأبلغتنى - فى لهجة شبه آمرة - بأن الديوان "اتجمع"، وأن الفنان منير الشعرانى "عماد حليم" قد أنجز الغلاف، والأمر لا ينتظر سوى مراجعتى، وإصدار موافقة بالنشر.

لم أستطع بالطبع مجاهدة سلوى فى هذا الأمر، رغم أنه كان بالفعل مفاجأة كاملة لى، خاصة أنه كتابى الأول، إلا أنه كان يداعب رغبة دفينة فى داخلى فى إصدار كتاب، وهى رغبة النشر- المختبئة، ولم أنتظر كثيرا حتى تلقيت مكالمة من راوية عبد العظيم، تخبرنى فيها بالتعجيل لكى أذهب لمراجعة الديوان، وبالفعل ذهبت فى اليوم التانى لكى أحصل على المخطوطة بعد أن تم جمعها، كانت الدار تشبه قلعة ثقافية حصينة، الجدران كلها مغطاة بالأرفف التى تحمل كتبا، وعلى يسار الداخل كان مكتب "الأستاذة" راوية عبد العظيم، كان المكتب صغيرا، يوحى بأنه مكتب عمل يضج بالحيوية، لأنها كانت تعقد فيه اجتماعاتها كلها، وكان الوقت مزدحما للتجهيز لمعرض الكتاب، استقبلتنى هاشة وباشة وبابتسامة مبهجة، وأحضرت لى المخطوطة، وأبلغتها بأننى سآخذها وأعيدها بعد أيام معدودات، فوجئت أنها اندهشت بشكل أربكنى، وقالت لى بمرح: "أنت لسه هتاخد الديوان البيت، مفيش وقت، أنت لازم تراجعه هنا وتخلصه النهارده، وتسلمه، وتوقع بنشره، يارب تقعد فى المكتب للصبح"، قالت هذا بطريقة شبه حاسمة وآمرة، ولكنها أضافت بلطف ومداعبة: "احنا بنسابق الزمن" وعماد حليم عامل غلاف للديوان تحفة وبمحبة كبيرة، وموصينى ع الديوان، وأنا مقدرش أكسّر له كلام"، قالت ذلك وكأنها لا ولن تنتظر ردا منى أو تعقيبا أو مجادلة، كانت طريقتها كطريقة قائد عسكرى فى ميدان يوزّع المهام العاجلة بخبرة محارب قديم ومسئول ويدرك طبيعة تلك المهام، وكان يتم كل ذلك دون أى تعقيدات وبسلاسة شديدة، ووسط ردود على تليفونات من كل حدب وصوب، وتوقيع أوراق، حيث أن ذلك العام بالتحديد بدأ نجم "دار سينا" يصعد بقوة مدهشة لأسباب سوف نأتى على تفصيلها لاحقا.
من هنا بدأت أولى خطواتى فى النشر مع دار سينا، ومع راوية عبد العظيم، ولا أنكر أننى كنت محظوظا بتلك الصحبة التى توفّرت فى ذلك الوقت، وتكاتفت وتحالفت على نشر ديوانى الأول عن دار نشر صار لها الحضور الأهم والأوسع والأخطر فى مرحلة محورية فى تاريخ النشر فى مصر، ولا يستطيع أى باحث أو قارئ لمشهد النشر فى مصر، أن يفصله عن مجريات المشهد السياسى، وجدل الرسمى مع المتمرد عليه، وصراع الهامش مع المتن، وتشابك كافة المعطيات الثقافية والفكرية والاجتماعية مع الأحداث السياسية فى عمومها، والتى تعطى الزخم الذى عرفناه فى عقد التسعينات من القرن العشرين، وبالطبع كان ذلك الزخم الذى شاركت فيه دار سينا بقسط وافر لا ينفصل بشكل حاسم وقاطع عن ماحدث فى عقدى السبعينات والثمانيات، وبالطبع كانت دار سينا فى قلب ذلك الزخم، إحدى أشكال ومضامين وقلاع الإلهام التى تعاطت معها دور نشر لاحقة.
ومن دواعى نجاح دار سينا أن تكون سيدة من طراز خاص وخبرة مدججة بالتجارب فى مجال النشر والكتاب مثل رواية عبد العظيم، رغم خشونة مجال النشر وأهله والصراعات المعروفة والتحديات المعتادة فى إطار هذا المجال، إلا أن راوية استطاعت أن تقود زورقها فى خضم أمواج عنيفة سياسيا واقتصاديا وثقافية ودينيا، ذلك الخضم الذى كان محتدما بدرجات متفاوتة، منذ مطلع عقد السبعينات، حتى أن رفعت راوية اسم "دار سينا"، لتضع مكانها "دار العصور الجديدة"، ربما يكون ذلك الأمر حدث لأسباب مطاردات ضرائبية أو سياسية، وهذا حدث مع دور نشر كبيرة من قبل، مثل دار الثقافقة الجديدة، والتى كان اسمها "مكتب يوليو" سابقا، ثم "دار العالم الثالث" لاحقا، ولكننى لست مشغولا بهذا الأمر، لأنه أمر يطول فيه الشرح والكلام، ولكنى معنى بإعطاء لفتة سريعة كنظرة طائر _كما يقولون_حول الظرف السياسى والفكرى السبعينى الذى ولدت فيه حركة راوية عبد العظيم ورفاقها، ذلك الظرف المشحون باحتجاجات وانتصارات وهزائم عاشها الجميع، وتحت وطأة انقلابات حادة فى المزاج الثقافى العام، ذلك الذى أدى إلى حالات النشر المتنوعة فى الثلث الأخير فى مصر من القرن العشرين.
 راوية عبد العظيم
راوية عبد العظيم
المناخ الذى تكونت فيه راوية عبد العظيم:
"لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها"، هكذا لا يعرف مشقات النشر والمنع والقمع والمطاردة والسجون والمعتقلات فى مصر، إلا من عاشها وذاق مراراتها، واضطر كثير من الكتّاب والأدباء والمبدعين أن يذهبوا بمؤلفاتهم إلى دمشق أو بيروت أو بغداد، ويظل الكاتب ينتظر شخصا قادما من تلك العواصم، حتى تصله نسخة أو أكثر، ويلتقى الحبيبان: المؤلف وكتابه، هكذا نشر يحيى الطاهر عبدالله أجمل إبداعاته "الدف والصندوق" فى العراق عام 1974بمقدمة نقدية طويلة للأستاذ ادوار الخراط، وكذلك نشر جمال الغيطانى درّته الأولى "الزينى بركات" فى دمشق 1974، ونشر أمل دنقل ديوانه الأول "البكاء بين يدىّ زرقاء اليمامة" فى بيروت 1969، ذلك الاضطرار كانت تسبقه أسباب واضحة تماما، فحواها أن خصومة حادة اشتدت بين المثقفين الطليعيين والتقدميين والماركسيين والقوميين والشباب من جهة، وبين النظام من جهة أخرى، وذلك منذ مطلع عقد السبعينات، وربما قبل ذلك بقليل، أى قبل رحيل الرئيس والقائد التاريخى لثورة 23 يوليو 1952، عندما احتدمت الصدامات الجماهيرية بعد صمت طويل منذ أحداث فبراير ومارس 1954، وخرجت الجماهير فى 21 فبراير 1968، وكان الدافع الأول والمفجّر لتلك الصدامات، هو حكم المحكمة فى قضية ضباط سلاح الطيران المتهمين بالإهمال فيما يخص نكسة أو هزيمة 1967 الكارثية، بدأت الانتفاضة فور نطق الأحكام، وكان عمال حلوان هم أول من بادروا، وكذلك الطلاب، وكان الخروج عفويا، رغم أنه تصادف مع يوم الطالب العالمى، وكما يرصد أحمد عبدالله فى كتابه "الطلبة والسياسة فى مصر"، والذى قامت بترجمته إلى العربية الأستاذة إكرام يوسف، وصدر عن دار سينا للنشر عام 1971: "..وتحولت الاحتفالات بذلك اليوم إلى سلسلة من حلقات النقاش السياسى، حيث حاول المسئولون فى الجامعة والحكومة الرد على تساؤلات الطلبة، ولكن فى حذر، وبعد استيعاب تلك المظاهرات بالاستقطاب مرة، وبالتهديد مرة أخرى، وبالقبض على القيادات مرة ثالثة، تمت تهدئة الأوضاع، ولكنها تجددت مرة أخرى فى نوفمبر من العام نفسه فى مدينتى المنصورة والإسكندرية، وكتب محمد حسنين هيكل مقالا فى زاويته الشهيرة "بصراحة"، وتحت عنوان "قضية الشباب"، ولوّح بأننا "يقصد رجال السلطة" لا بد أن نعترف بوجود قوة جديدة فى المجتمع، هذه القوة لا بد أن تجد مجال تعبيرها المتنوع، واعتبر أن ما يحدث فى مصر هو امتداد لثورة الشباب فى العالم كله، وأشار إلى أن مروقا ما من الممكن أن يحدث، وذكر على سبيل المثال، شباب الهيبز، ووصفها بأنها حركة منحرفة وشاذة، ولكننا سوف نستمع إلى من هم الأصوب والأكثر جدية، ولم ينس هيكل، وهو رئيس تحرير الجريدة، أن يضع عنوانا معاديا يقول: "الأيدى الخفية وراء حادث الإسكندرية"، وفى متن التقرير، اعتبر المحرر أن مظاهرات الإسكندرية والمنصورة أسفرت عن وجود عناصر مغرضة وخفية، وشوهدت تلك العناصر بتوصيل بيانات إلى بعض السفارات الأجنبية- تهمة شائعة- ووعد المحرر بأنه سوف يكشف عن تلك العناصر فى حينه.

ورغم ترصد السلطات آنذاك لمن أطلقوا عليهم "العناصر الهدّامة"، إلا أنها فتحت ثغرة فى الجدار الصلب القامع والمانع للحريات، ففى المجال الثقافى حدثت تطورات ذات شأن كبير، إذ صدرت مجلة شبه مستقلة فى مايو 1968، وتحمل إعلانا مدفوع الأجر من وزارة الثقافة، ولكنها تنطوى على أسماء طليعية، رغم أن كان على رأسها الشاعر أحمد مرسى "رئيس التحرير"، ويعتبر هذا الاسم لا غبار عليه من اليمين أو اليسار، وكتب مقدمة نموذجية محايدة، ولا تحتاج منا لفائض شرح أو تحليل لوصف أن المجلة جاءت لاستيعاب حركة المثقفين بدرجة ما، وعدم إغضابهم من ناحية أخرى، وخلق قناة لكى يعبّروا عن أنفسهم أدبيا وثقافيا وفنيا من خلالها، دون التعبير السياسى المباشر، وهذا ما عبّرت عنه المقدمة اللافتة، والتى تحدثت عن الأوضاع بشكل عام، دون التورط فى أى تفاصيل، وأجد نفسى مضطرا لنقل المقدمة "القصيرة" كاملة، حيث أنها تعبّر عن الوضع المعقد والتفاهى الذى وصلت إليه الصيغة بين المثقفين والسلطة فى مرحلة انتقالية:
(يعيش الوطن العربى هذه الأيام، تجربة هذه الأيام، تجربة مخاض عظيمة وأليمة، ذلك لأن النكسة التى حلّت بأمتنا لم تكن نهاية فى حد ذاتها، بل كانت الثمن الفادح للوقوف على الحقيقة عارية، وهذه هى الحقيقة على الأرض الصلدة التى نقف عليها بأقدامنا اليوم، فى انتظار لحظة الميلاد المجيد.. وبصدور العدد الأول من مجلة 68 فى ظل الأحداث التاريخية والمصيرية التى تشهدها البلاد، لا يسع المجلة إلا أن تقطع على نفسها عهدا بأن يكون لها شرف وضع لبنة متواضعة فى صرح الوطن الاشتراكى الديمقراطى الحر... وعلى الرغم من أن مجلة 68 ليست مجلة سياسية، فهى تؤمن بأنها لو نجحت فى الكشف عن حقيقة ما يختلج فى جوانح الكتّاب والشعراء والفنانين من أبناء جيل اليوم، تكون قد أوفت بالعهد الذى قطعته على نفسها، بالمشاركة فى معركة التحرير والبناء، ولا يفوت أسرة تحرير المجلة، فى هذا الصدد، أن توجه الشكر إلى جميع الأصدقاء والزملاء من المثقفين والشعراء والفنانين الذين ساندوا المجلة منذ أن كانت فكرة وحلم، فبدون هذه المساندة المادية والرمزية، لما كان فى الوسع ترجمة الفكرة والحلم فى الواقع".
أعتقد أن هذا بيان دقيق ومركب لصياغة العلاقة بين المثقفين والسلطة فى لحظة احتدام عارمة بينهما، الطرفان يحتاجان لتلك الصياغة، الطرفان مضطران لعقد هذه العلاقة، إنها صياغة آمنة للجميع، أى المتن والهامش، والمثقف والسلطة، مع اعتبار أن كل طرف له عشرات الملاحظات حول الآخر، وعشرات المحاذير أيضا، ولكن عملا بقاعدة المتنبى قديما "من نكد الدنيا على الحرّ، أن يرى عدوا له، ما من صداقته بدّ"، وجدا الطرفان أنفسهما فى علاقة مضطربة، وليس مطلوبا من المثقف والكاتب والمبدع فى مثل هذه الظروف أن يكون انتحاريا، وهكذا سارت وصارت العلاقة بين المثقفين والسلطة، علاقة على جسر من الأشواك، علاقة تحت فوهات المنع والقمع والإبعاد والسجن والاعتقال إن تطلّب الأمر بالطبع، وكل طرف يحاول أن يمرّر أفكاره بآلياته الخاصة، حتى لو ابتعدت عن المساحات الملتهبة، علاقة اضطرارية سرعان ما تعود إلى طبيعتها الصدامية، ولكن السنوات القليلة التى تلت نكسة 1967 شهدت تلك الانفراجة، ولكن تحت كافة أشكال الرقابة.
وشهد عاما 1968و1969 أشكالا من التعبير المستقلة التى سمحت بها الجهات المسئولة، ولكن تحت عينها وبصرها، ومن يتجاوز فهناك وسائل العقاب والردع والمصادرة، وكانت التجليّات الثقافية واضحة ومعلنة وجريئة إلى حد كبير. ففى ديسمبر 1968 صدرت مجموعة قصصية مشتركة عن سلسلة مستقلة، وهى سلسلة "كتابات معاصرة"، وكان يشرف على السلسلة الفنان صبحى الشارونى، وتضمنت المجموعة كتابات قصصية لكتّاب كبار، وعلى رأسهم نجيب محفوظ ويحيى حقى ويوسف الشارونى وغيرهم، وكتب غالى شكرى دراسة مستفيضة تحت عنوان "بعيدا عن أزمة القصة القصيرة"، وكانت هذه المجموعة تمثّل الجزء الأول، وصدرت مجموعة ثانية فى عام 1969 ضمت كتّابا آخرين، وكتل لها دراسة نقدية الناقد جلال العشرى، تحت عنوان "عاصفة القصة القصيرة"، ولا نغفل هنا الدعم الذى كانت تقدّمه مؤسسات رسمية مثل منظمة التضامن الأفروآسيوى فى صورة إعلانات، والتى يرأسها يوسف السباعى، كما تضمنت إعلانا عن سلسلة جديدة مستقلة عنوانها "كتاب الطليعة"، يشرف على تحريرها القاص الشاب محمد سمير ندا، وبالفعل صدر منها الكتاب الأول للكاتب الشاب جمال الغيطانى، عبارة عن مجموعة قصصية عنوانها لا فت جدا وهو "أوراق شاب عاش منذ ألف عام"، وكتب لها مدير التحرير مقدمة، وهو الناقد الطليعى ابراهيم فتحى، ولكن الرقابة والجهات المسئولة اعترضت على تلك المقدمة، وتم حذفها، ولكن الغيطانى كان قد طبع منها عددا كبيرا وكان يوزعها بشكل مستقل مع المجموعة، واكتفى المحررون بكتابة بيان قصير أتى فى نهاية الكتاب جاء فيه: "..بصدور هذا الكتاب، تبدأ سلسلة جديدة تحتضن التجارب الواعدة، لأدبائنا الشباب، لتساهم ماوسعها الجهد فى حل مشكلة النشر بالنسبة لهم، مقدمة لهم زادا من الخبرة المدعمة بالإخلاص والصدق، إبمانا منها بما يمكن أن تقوم به الكلمة الملتزمة فى حياة الشعوب، إن هذه المحاولة مجال مفتوح لكل تجربة طليعية مصرية أصيلة، لا تصد عن المغامرات الفنية، ولا تلتزم إلا بالصدق مع الفن ومع الجماهير، فى هذه المرحلة من تاريخ النضال المصرى والعربى..".
ولأن صوت الأدباء الشباب فى مصر، أصبح له الحضور الأقوى فى الساحة الثقافية، أعدّت مجلة الطليعة اليسارية ملفا شاملا تحت عنوان "هكذا يتكلّم الأدباء الشباب"، وكان الملف بمثابة استطلاع واسع، وقراءة فى عقول هؤلاء الشباب الذين فرضوا أصواتهم بقوة، وأصبحوا طرفا راجحا فى المعادلة الثقافية لا يمكن تجاهله، ووجهت الطليعة ثلاثة أسئلة، راعت فيهم كثيرا من الدقة والحذر، حيث لا تجاوز للحدود المسموح بها فى السؤال والإجابة فى الوقت ذاته، وجاءت الأسئلة على النحو التالى:
(1)متى قامت العلاقة بينك وبين الفن الذى تمارسه الآن، ومتى بدأت الإنتاج فيه؟
(2)ما هو المناخ الذى يسيطر على ممارستك لفنك من حيث:
_العلاقة بينك وبين زملائك الفنانين والأجهزة والمؤسسات المتصلة بهذا الفن
_والعلاقة بينك وبين المجال الذى تعمل فيه سواء كان مجالا فنيا غير ذلك.
_الموقف من الأجيال الفنية السابقة على جيلك وعلاقتك بها.
(3)ما هى المؤثرات الاجتماعية والفكرية والفنية التى تشارك فى إبداعك الفنى، ةأين تقف_بهذه المؤثرات_ من قضية التغيير الاجتماعى من بلادك_بشكل عام_، وقضية العدوان الإسرائيلى، وقضايا العالم المعاصر).
هذه هى الأسئلة التى وجهتها مجلة الطليعة إلى الأدباء الشباب، وكان من بينهم جمال الغيطانى ويوسف القعيد وعبد الحكيم قاسم وفؤاد حجازى ورضوى عاشور وصبرى حافظ وأمل دنقل وسمير عبد الباقى وغيرهم من الأدباء الذين ملأوا الدنيا فيما بعد، وشكّلوا مايسمى بظاهرة جيل الستينات، وجاءت تعقيبات تحليلية حول الملف بأقلام سامى خشبة، ود. سهير القلماوى، ود. لويس عوض، ود. على الراعى، ود. لطيفة الزيات، ولطفى الخولى وغالى شكرى، وتراوحت تلك التعقيبات بين الاحتفاء بالظاهرة، مثلما فعل سامى خشبة، فبعد أن أقرّ بأن ذلك الجيل "نشأ على حجور أجيال سبقته، آباء وأجداد"، تساءل: "..ولكن، أمن الحقيقى أن قد أصبح لجيلنا كيان عقلى وروحى متميز وخاص؟"، واستغرق المقال كله إجابة وتأكيد على أن ذلك الجيل استطاع أن يثبت حضورا متميزا بين الأجيال الأدبية، كما أن سهير القلماوى تساءلت : أين تكوينهم الثقافى، وأكّدت أن ظاهرة العقاد لن تتكرر، وهكذا راح المحللون والنقاد يثيرون أسئلة ذات آفاق حقيقية، أما الأدباء أنفسهم فأعلنوا عن أنفسهم بدرجات منفاوتة، دون التعرض لهيبة النظام، للدرجة التى أخفى بعضهم ظروفا غير ديمقراطية _على المستوى السياسى_ كانوا قد تعرضوا لها، فلم نجد _مثلا_ فؤاد حجازى وصبرى حافظ وعبد الحكيم قاسم وسمير عبد الباقى أتوا بأخبار اعتقالات لهم قد حدثت فى الماضى القريب، ولكنهم قفزوا على تلك الأخبار لعدم تعكير الجو، أو لضمان مرور شهاداتهم فى ذلك الظرف.
ولم تمر أسابيع قليلة، حتى سعى أدباء جادون، وعلى رأسهم القاص محمد صدقى، لعقد مؤتمر لأدباء مصر فى الأقاليم، ولم تفوّت الجهات المسئولة تلك الفرصة، فتبنّت الاقتراح، ودعت له، وعملت على رعايته الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، ورشحوا الأديب الكبير نجيب محفوظ ليكون أمينا عاما للمؤتمر، والدكتور على الراعى أمينا مساعدا، كما شكلوا لجانا عديدا، مثل لجنة القصة التى يرأسها الدكتور يوسف ادريس، ولجنة الشعر التى رأسها صلاح عبد الصبور، ولجنة النقد التى ترأسها أحمد عباس صالح، وغير ذلك من اللجان، ولكن المدهش لنا الآن أن يكون رئيس المؤتمر هو وزير الداخلية بنفسه شعراوى جمعة، والأكثر إدهاشا وربما إعجابا أن نجيب محفوظ يعتذر عن ترشيحه لأمانة المؤتمر دون إعلان أسباب واضحة، وفى التغطية الوحيدة التى قرأتها فى مجلة المجلة "يناير 1970"، لم يشر الكاتب صبرى حافظ إلى ذلك الاعتذار، ونوّه على أن المؤتمر جاء نتيجة جهود طويلة المدى، وانعقدت سلسلة مؤتمرات صغيرة فى الأقاليم لتصل إلى 70 فعالية، لكى تصب فى ذلك المؤتمر الكبير، ومما لا شك فيه أن ذلك المؤتمر كان محطة كبيرة لصعود أسماء شابة كثيرة من الأدباء، وقررت أمانة المؤتمر إصدار مجلة للثقافة الجماهيرية، وقد صدر العدد الأول بالفعل من مجلة "الثقافة الجديدة" فى أبريل عام 1970.
هذه هى الأجواء التى عاشها جيل من المثقفين والمبدعين والكتّاب، وعلى رأسهم الناشرة راوية عبد العظيم، والتى شاركت فى كافة أشكال الاحتجاج الأولى، وكانت ضمن الذين شكلوا لجنة لرفض مبادرة روجرز عام 1971، وتم القبض عليها مع رفاق لها من المثقفين الوطنيين، وخاضت رحلة طويلة فى عقد السبعينات والثمانينات، حيث ذهبت للعمل فى بيروت، وعادت لكى تعمل فى دار الثقافة الجديدة، ثم فى مكتبة مدبولى، وتقترب من عالم النشر بشكل عميق، وتعرف أسراره، حتى تفتح دار سينا للنشر فى النصف الثانى من عقد الثمانينات، وكان الكاتب الصحفى عادل حمودة داعما كبيرا لها فى إدارة النشر، ونشر بعضا من كتبه فى باكورة الإصدارات، وكان أولها: "اغتيال رئيس بالوثائق: أسرار اغتيال أنور السادات" 1985، ثم "سيد قطب من القرية إلى المشنقة..تحقيق وثائقى" 1987، وهكذا اتضح دور الدار منذ اللبنات الأولى فى إصداراتها، وهذا كان متوائما مع المناخ العام الذى كان معاديا للإسلام السياسى، والذى بدأ يستعيد نفسه بقوة بعد حالة الجذر التى أصابته إثر اغتيال رئيس الجمهورية محمد أنور السادات فى 6 أكتوبر 1981، وينظّم صفوفه من جديد فى عدد من التنظيمات التى تستمد قوتها من التراكم الذى حدث فى عقد السبعينات، ولاحظنا أن كثيرا من شيوخ الإسلام السياسى يعودون مرة أخرى، وبقوة، وكذلك التنظير لعودة الخلافة بدأ يجد له منظّرين جددا، مما دفع بعضا من الباحثين للتصدى لتلك الظواهر التى استفحلت وتضخمت وراحت تتغلغل فى أوصال الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
كيف تأسس الخطاب المستنير، وظهور فرج فودة:
كان اغتيال الرئيس محمد أنور السادات فى 6 أكتوبر 1981، مؤشرا واضحا وقويا لضلوع خطاب الإرهاب السياسى فى تشكيل تيار واسع ومؤثر ومتغلغل فى المجتمع ومؤسسات الدولة الكبيرة، وحدث هذا بعد سلسلة أحداث كارثية معروفة فى عقد السبعينات، وكانت خطابات الإسلام السياسى ننعدد وتتنوع أشكالها، وهناك ثمة عوامل كبيرة ساعدت على تغذية ذلك الحطاب الدينى فى أدنى صوره، منها ظاهرة الشيخ عبد الحميد كشك الذى جعل من مسجد عين الحياة فى شارع الملك الكائن بمنطقة حدائق القبة، شرق القاهرة، مدرسة جماهيرية واسعة لتدريب الناس على نوع خطاب دينى معين، واستقطابهم يشكل حاسم لذلك الخطاب، وكنت أرى الناس كيف كانوا مسحورين بذلك الخطاب، تدريب غير عادى على الرفض لكل مظاهر المدنية والفن، وإدراجها فى مساحة الحرام، والدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، والتوسيع والتعميق من خطاب المظلومية الذى كان مطروحا آنذاك منهم، ضد عصر جمال عبد الناصر بكامله، وكان انتشار برنامج الدكتور مصطفى محمود "العلم والإيمان" أحد العناصر المساعدة، لترويج خطاب الدروشة، فضلا عن دروس وخطابات الشيخ محمد متولى الشعراوى، وطريقته الآسرة والجاذبة لقطاعات واسعة من الناس، وكان ذلك الثلاثى "كشك ومصطفى محمود والشيخ الشعراوى" عاملا مساعدا لنمو هذا الخطاب الدينى، رغم ما كان يبدو من سماحة على خطاب الدكتور مصطفى محمود، والحكمة والبلاغة عند متولى الشعراوى، وكانت كذلك عودة مجلة "الدعوة" الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين عام 1976 ساحة واسعة ومؤثرة فى نشر ذلك الخطاب المتطرف، واستعادة كتابات حسن البنا وسيد قطب وعبد القادر عودة وكل قيادات ورموز الجماعة، كل هذا وغيره، ساعد على نشر الخطاب المتطرف، وبالتالى تشكّلت على أساس ذلك الخطاب كافة التنظيمات المتطرفة، وبالتالى وقعت أحداث جسام فى عقد السبعينات، انتهت بالحدث الأكبر، وهو اغتيال رئيس الجمهورية شخصيا، بعد أن أفسح لهم الطريق، ثم اختلفوا معه بعدما اشتد عودهم، ودبروا للتخلص منه وفق خطة محكمة شاركت فى تنفيذها ووضع خطوطها وخطواتها عناصر عديدة، ولم يكن الضابط خالد الاسلامبولى سوى أداة تنفيذية للخطة، بينما كانت الخطة تشمل رؤوسا أخرى.
ولا نستطيع أن نقول بأن عقد السبعينات مرّ دون أن تكون هناك بعض أقلام مضادة لخطاب التطرف، وتتعقبه بقدر ما تستطيع تلك الأقلام، وقرأنا لكتّاب ومثقفين وباحثين كانوا كبارا، تصدّوا لذلك الخطاب المتطرف، منهم الدكتور يوسف إدريس والدكتور فؤاد زكريا والكاتب يحيى حقى والدكتور زكى نجيب محمود، ولا ننسى كتابات الدكتورة نوال السعداوى التى كانت تستفز أصحاب الخطاب المتطرف، وبرزت أقلام شابة جديدة على الساحة الثقافية والفكرية، ولكن كل ذلك الزخم التنويرى، لم يكن قادرا على صد أو رد التدفق الظلامى المدعوم بالأموال الخارجية، والمسنود برعاية بعض المؤسسات، فضلا عن تفريغ الحياة الثقافية من أى خطاب تنويرى، وإغلاق المجلات، وكانت تلك الأقلام التى أشرنا إليها غير متخصصة لمتابعة مؤسسات وفرق مدربة على بث تلك الخطابات، فضلا عن أجهزة الإعلام التى كانت تبث كثيرا من البرامج التى تخدم ما أسموه بدولة العلم والإيمان، فضلا عن "ثورة الكاسيتات"، وكانت كتب الشعراوى تطبع وتنشر فى مؤسسة أخبار اليوم بأسعار زهيدة.
بعد اغتيال الرئيس السادات، أدرك الجميع خطورة توغل الإسلام السياسى، ورغم القبض على عدد كبير من الجهاديين الذين خططوا للاغتيال، لكن ظلّت هناك جيوب تنظيمية تعمل بقوة فى الحياة السياسية، وكانت تلك التنظيمات تحاول من جديد استقطاب قطاعات واسعة من الذين كانوا متأثرين بالخطابات المتطرفة المتعددة، وبالفعل حدثت معارك ضارية بين أجهزة الأمن المصرية، وبين الأذرع العسكرية التى كانت التنظيمات الإرهابية قد دشنتها سريعا بعد القبض على عدد واسع من الإرهابيين وتوابعهم، ولكن ظلّت الماكينة الأم تعمل بقوة فوق السطح، وتحته إن تطلّب الأمر، أقصد جماعة الأخوان المسلمين.
ورغم أن قوى سياسية عديدة كانت تعمل فى ذلك الوقت، لكنها كانت ضعيفة على الأرض، وكان وجودها وجودا هشّا للغاية، بعد أن تم إنهاكها بشكل كبير، وخرجت القوى المتطرفة التى تعملقت فى السبعينات، شبه قادرة على تنظيم نفسها، ومن ثم كان من الضرورى أن تنشأ جبهة شبه مستقلة فكرية لمواجهة الخطاب الإرهابى، أو المتطرف فى أقل تقدير، وكان الدكتور فرج فودة المثقف والأستاذ فى كلية الزراعة والشاعر أحد أبناء تلك الجبهة المتناثرة من التنويريين الجدد، رغم انتمائه فى البدايات لحزب الوفد، ولكنه استقال عندما راح الحزب يعقد تحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات، ورأى أن حزب الوفد الذى نشأت أسطورته على فكرة الليبرالية،كيف يتحالف مع جماعة ضد الليبرالية فى أقل وصف لها، ومن ثم استقال من الحزب، ونشر كتابه الأول "الوفد والمستقبل" عام 1983، وفى هذا الكتاب يقرر ص 98 : "..إن الحزب السياسى المنظم، والقوى الوحيد فى الساحة السياسية المصرية الآن هو الحزب الدينى الإسلامى بكافة اتجاهاته، وهى اتجاهات قد تتنافر فى الأساليب، لكنها يمكن _بسهولة شديدة_ أن تتجمع فى إطار واحد يشمل الإخوان المسلمين "باتجاهاتهم" والجهاديين والقطبيين والتوقفيين والتكفيريين إلى آخر هذه الطوائف".
ويستطرد فرج فودة فى إيضاح خطورة ذلك الوضع، ويثبت أن كل هذه الجماعات المتطرفة تقوم نظريتها على الفكر السياسى، وأنها اتجاه عام فى جميع البلاد الإسلامية، وذلك تيمنا بما حدث فى الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخمينى، وتحدث عن أن الأوضاع السياسية فى البلاد الإسلامية، تأثرت بشكل بالغ بالثورة الإيرانية، لدرجة انقلاب المفاهيم والأطماع والطموحات والخرائط السياسية التى تسير عليها تلك الجماعات والأحزاب والكتل السياسية التى تختفى تحت مسميات دينية، وكتب يقول: "إن التنظيمات الدينية فى مصر قد غيّرت فى مفاهيمها المألوفة عنها فى الماضى، فبعد أن كان الإخوان المسلمون يعتمدون فى انتشارهم على الطبقات المتوسطة أساسا، ويتمركزون فى المدن بصورة عامة، استند تحركهم السياسى فى السنوات الأخيرة على عدة أساليب، أولها: أسلوب قديم وهو التركيز على الشباب المتدين فى الجامعات، وهو أسلوب كان نجاحه فى الماضى محدودا لوجود قوى سياسية شعبية مناهضة، لكنه فى ظل مناخ لا ديمقراطى نمى وترعرع حتى أصبح ظاهرة واضحة ومميزة..".
ويستطرد فرج فودة فى تحليل ظاهرة الإسلاميين السياسيين الجدد الذين يختفون تحت شعارات ومقولات دينية براقة، ولكنهم يخفون أغراضهم السياسية، وبعدها تفرّغ فرج فودة لمواجهة ذلك التيار الوحشى المتطرف، والمدعوم بقطاعات واسعة من الطبقات الاجتماعية المختلفة، والعائدة من الدول النفطية، مفعمة بالفكر الوهابى، والتنظير لتحريم الفنون البصرية والسمعية، وفرض الحجاب والتكريس له، وكانت مواجهة فرج فودة شبه منفردة وشجاعة ونادرة، وأدرك فرج فودة ذلك منذ البداية، أدرك دوره التاريخى المكتوب له، فلم يتراجع، ولم ينحن، ولم يخش التهديدات المتزاحمة عليه، وكان أول كتاب له بعد ذلك، هو قبل السقوط عام 1985، وكتب فى بدايته: "..لا أبالى إذا كنت فى جانب والجميع فى جانب آخر، ولا أحزن إن ارتفعت أصواتهم أو لمعت سيوفهم، ولا أفزع إن هاجمنى من يفزع لما أقول، وإنما يؤرقنى أشد الأرق، أن لا تصل هذه الرسالة إلى من قصدت، فأنا أخاطب أصحاب الرأى لا أرباب المصالح، وأنصار المبدأ لا محترفى المزايدة، وقصّاد الحق لا طالبى السلطان، وأنصار الحكمة لا محبى الحكم، وأتوجه إلى المستقبل قبل الحاضر، والتصق بوجدان مصر لا بأعصابها، ولا ألزم برأيى صديقا يرتبط بى، أو حزبا أشارك فى تأسيسه، وحسبى إيمانى بما أكتب، وبضرورة أن أكتب ما أكتب، وبخطر أن لا أكتب ما أكتب، والله والوطن من وراء القصد".
ومن هنا فتح فرج فودة الباب واسعا للمواجهة الفكرية المسلحة بأدوات بحثية وتنويرية جادة، ورؤية واضحة مستمدة من التاريخ "الإيجابى" المستنير، بعد أن أعلن عن نتائج البعد السياسى الخطير لتلك التنظيمات، وأصبحت المواجهة ضرورة حتمية لا مفر منها، وليست ترفا أو هواية يمارسها الكتّاب والمثقفون فى أوقات الفراغ، أو كلما حدثت بعض أشكال العنف العديدة، ولكن الأمر يحتاج لمثابرة ودأب وتكاتف وثقافة عادلة وديمقراطية، كل ذلك كان لكشف ّكل أشكال العوار التى انتابت الثقافة المصرية التى تم تشويه مساحات منها، والعقل الجمعى المصرى الذى استقرت فيه بعض الأفكار المتطرفة، والتى سيّدت نوعا من العنف المجتمعى المتنوع فى كل مناحى الحياة، ومن ثم استعادت الدولة كثيرا من مثقفيها وقوتها الناعمة التى كانت فى الخارج، منهم الدكتور غالى شكرى والدكتور جابر عصفور والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى ومحمود أمين العالم، وغيرهم ليكونوا فى صدارة المشهد الفكرى والثقافى، وكان فرج فودة فى ذلك الوقت يؤسس للتيار المستنير، ويخوض معارك ضارية وسط حملات تشهير من جهات عديدة، حيث أن تلك الجهات أن تقصف جبهته بشائعات كثيرة، خاصة بعد أن أصدر كتابه الثالث "الحقيقة الغائبة" عام 1987، ويناقش الحجة بالحجة كافة أطروحات الظلاميين الجدد، ومن واقع أوراقهم وكتاباتهم المعلنة والمستترة، ومما لا شك فيه أن طلقات فرج فودة أحدثت دويا وفزعا فى تلك التنظيمات، مما أثار حركتهم بالرد والتربص به، ومن ثم بدأ تيار تنويرى يولد من جديد.
دار سينا .. ورواية عبد العظيم ومعركة نصر حمد أبوزيد:
كان الانشغال الأكبر فى عقد الثمانينات من القرن العشرين، هو ملاحقة الفكر الظلامى الذى توغل فى كافة طبقات المجتمع، وفى المؤسسات الحكومية الواسعة، خاصة المؤسسة التعليمية التى كانت ومازالت تختار نصوصا دينية فى كتب القراءة، وتعمل على تفسيرها تفسيرات مغرضة، ومن هنا نشطت كثير من دور النشر الخاصة والمستقلة فى نشر كتب تناقش الحالة الدينية المتطرفة فى مصر، وكانت دار الفكر للدراسات والنشر ضالعة فى ذلك النشر، فنشرت الطبعة الثالثة من كتاب "الحقيقة الغائبة" لفرج فودة، و"الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة" 1988، كما نشرت كتابا مهما للدكتور محمد رضا محرم هو "تحديث العقل السياسى الإسلامى"، وبدأت دور النشر تنتبه لتوغل الإسلام السياسى، وتميّزت دار سينا فى ذلك المجال بقوة لا حصر لها، واعتبرت أن الأمر بمثابة معركة ضارية أمام ذلك التيار الرجعى الذى جرّ البلاد إلى كوارث عنف نوعية فى المجتمع المصرى.
 الإمام الشافعى
الإمام الشافعى
كما أسلفنا من قبل، كانت راوية عبد العظيم قد اكتسبت خبرة عميقة على التعامل مع الكتاب، وذلك بعد خبرة سياسية مع التعامل مع التنظيمات السياسية الطليعية، ولذلك كان مزاجها العام، وثقافتها تميلان نحو تغليب الفكر الطليعى فى عمومه، ولم تتقيد فى النشر بالاتجاهات الماركسية التى شاركت فى حراكها السياسى، وذلك فى مصر وفى بيروت، وعملها فى مكتبة مدبولى، وفى دار الثقافة الجديدة، وفى دور نشر بيروتية، أكسبوها تلك الروح الرحبة التى تعمل على قبول الآخر، طالما كان تقدميا وطليعيا فكرا وسلوكا، وكان وجود الكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة وأول من شارك معها فى صياغة التوجه العام لدار سينا منذ أواخر عقد الثمانينات، أعطى للدار روحا وملامح بارزة، خاصة مع صدور كتابيه عن سيد قطب وعن قتلة السادات، ولم يخل الأمر بالطبع من الكتب المثيرة، مثل الكتب الصحفية التى تناقش أحداثا ذات صوت عال، ومنها كتاب "عامر وبرلنتى ..الحكاية ..القضية..الحكم..الوثائق"، للكاتب عبدالله إمام، والذى كان يرد فيه على الفنانة برلنتى عبد الحميد، وكان الكتاب من بواكير النشر فى دار سينا، ولا ننسى كذلك صدور ديوان شعرى صغير للفنانة رغدة، عنوان "مواسم العشق"، وأعتقد أننى قرأت عنه مقالا للدكتور صلاح فضل فى مجلة المصور.
كانت هذه البدايات ليست حاسمة تماما لتمييز ملامح ووجوه دار سينا، ومع اشتداد معركة التنوير مع التطرف، ومع بدايات عام 1990وانضمام الفنان الكبيرعماد حليم "منير الشعرانى" إلى الدار، والذى جعل للدار من خلال أغلفته المميزة، شخصية خاصة جدا، وكان القارئ يعرف أن الكتاب صدر عن دار سينا قبل أن يطلّع على ترويسة الصدور، وأصبح الشعرانى المسئول الفنى عن المنشورات، وكذلك لم يكن بعيدا عن نوعية إصدارات الدار، وكانت هناك مناقشات حادة بدأت تتسلل إلى دوائر ثقافية وفكرية مصرية حول موضوع الخلافة الإسلامية، وكانت الثورة الإيرانية عامل إلهام قوى لكافة التيارات الإسلامية، ليس فى مصر فقط، بل فى جميع الدول التى تعتنق الإسلام فى العالم العربى، وخاصة الجزائر، ومن ثم صدر كتابان عن الدار يتصديان لتلك المناقشات الدائرة والساخنة، والتى كانت تنبع من قوى استعراضية للتيارات المتطرفة التى كانت تعمل على قدم وساق فى اختراق النقابات القوية، خاصة نقابة الأطباء، ونقابة المهندسين.
كان الكتاب الأول الذى صدر عن دار سينا، هو كتاب "الخلافة الإسلامية" للمستشار محمد سعيد العشماوى، الذى صدر فى العام 1990، وناقش فيه العشماوى كل الأفكار التى كانت تدور فى ذلك المجال، بداية من الأصول العامة للخلافة الإسلامية، مرورا بتاريخ الخلافة، ثم فقه الخلافة الذى تأسس فى أروقة سياسية بشكل محض، ويقول الكاتب بشكل واضح فى مقدمة الكتاب لعرض ماجاء فى متن الكتاب: "..وهل يوجد مايمكن أن يسمى فقه الخلافة، ولم كان! وماهو هذا الفقه؟ وبعد ذلك يرد بحث تعرّض لدعوى معاصرة تحت عنوان (فقه الخلافة) بقصد تقويض كل نظم الحكومات فى البلاد الإسلامية، لا بنظام أفضل وأرقى وأسمى وأكثر تحديدا وأشد شمولا، ولكن بنظام الخلافة الإسلامية الفاسد والمعيب بعد حجب كل نقد عنه ونزع كل مثلب منه"، وهكذا يعلن الكتاب والكاتب عن توجههما، وكذلك عن توجه الدار التى بدأت تواجه حربا شعواء ضدها وضد صاحبتها، وكان الكتاب قد خطا خطوة واسعة فى تقديم مبررات وافية لفساد ماكان مطروحا حول مايسمى الخلافة الإسلامية، تلك الخطوة التى قفز بها العشماوى، كانت أكثر تطورا من خطوة الشيخ على عبد الرازق الذى نفى بشكل قاطع أن يكون للخلافة أى ذكر فى القرآن والسنة، ولكن العشماوى كتب حول فساد الفكرة ذاتها بشكل تفصيلى.
وفى العام ذاته صدر كتاب آخر لعالم جليل وهو الشيخ خليل عبد الكريم كان عنوانه "الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية"، ويرد فيه الشيخ خليل على هؤلاء الدعاة الذين لا يعرفون تلك الأصول التى جاءت منها الشريعة الإسلامية، فهم _أى الدعاة_ كانوا دائمى السباب لفترة الجاهلية، أى الفترة التى سبقت البعثة المحمدية، ووصفوها بنعوت بشعة، كما وصفوا عرب الجزيرة بأوصاف كريهة حتى ترسّخ فى الأذهان أن تلك الحقبة لم تكن سوى مجموعة من الظلاميات والجهالات والأضاليل، وأن أهلها ليسوا إلا حفنة من المتبربرين المنحلين، عديمى الفكر فاقدى الثقافة فاسدى الخلق كما شاع فى المسلسلات التلفزيونية الرديئة، ويعتقد هؤلاء الدعاة الجدد أن ذلك المنحى يخدم الفكرة الإسلامية، وهم بذلك على النقيض تماما، ومن هنا تنطلق أطروحات الشيخ خليل الذى يرى بأن من السخف أن القرآن سوف يخاطب قوما ويجادلهم بهذه الصفات، وينطوى الكتاب على التشريعات التى أتى بها الإسلام، وسوف يعجب القارئ_كما يقول عبد الكريم_ عندما يدرك أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشئون الدينية أو التعبدية : "..أخذ منها فريضة الحج وشعيرة العمرة وتعظيم الكعبة وتقديس شهر رمضان وحرمة الأشهر الحرام وثلاثة حدود، الزنا والسرقة وشرب الخمر وشطرا كبيرا من المسئولية الجزائية مثل القصاص والدية والقسامة والعاقلة .. إلخ"، ومن ثم جاء الكتاب لقلب مفاهيم الدعاة الجدد رأسا على عقب، وبهذه المناسبة كان بعض هؤلاء الدعاة الجدد، يرفعون قضايا على الكاتب، وبالتالى على الدار وصاحبتها، وشهدت محاكم ذلك الوقت صولات وجولات حول مطبوعات دار سينا للنشر، وكانت السيدة راوية عبد العظيم اسمها يرد كثيرا فى محاكم القاهرة، باعتبارها مروجة لأفكار مضادة للإسلام الحنيف.
ولم ينصرم عام 1990 حتى صدر كتاب آخر ذو طبيعة إشكالية، وهو كتاب "الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة الإسلامية" للدكتور سيد محمد القمنى، وكان القمنى قد نشر هذه الدراسة فى إحدى الدوريات العلمية عام 1987، وأثارت ردود فعل متباينة، مابين رافض ومؤيد، وبين الرفض والاستهجان الذى حدث، لم يكن الجدل قد توقف، ومن هنا التقطت الناشرة الذكية والشجاعة الخيط مرة أخرى، ونشرت البحث فى كتاب لكى يكون بين يدى القراء بشكل واسع، وكتب مقدمة للكتاب الشيخ خليل عبد الكريم، والذى أثنى بدوره على الكاتب والكتاب الذى دخل فى المعترك، ويشارك فى معركة التنوير القائمة، فى مواجهة الظلاميين الجدد.
وبعد سلسلة إصدارات فكرية وأدبية عديدة، جاء عام 1992، ذلك العام الذى شهد فى منتصفه اغتيال الكاتب الشجاع فرج فودة، إذ لم يجد الظلاميون وسيلة دفاع عن أنفسهم سوى القتل والاغتيال، بعدما انعدمت كافة البراهين والأدلة التى يردون بها على كل الحجج والبراهين والأدلة التى وجهها لهم فرج فودة ومن على دربه، وفى بداية العام صدر كتاب أثار لغطا كبيرا فى مصر والعالم العربى، الكتاب "الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية" للدكتور نصر حامد أبوزيد، وكان الكتاب مقدما ضمن المستندات التى بموجبها يحصل الباحث على درجة أستاذ، ومنذ ذلك الوقت بدأت الحرب الشعواء المعروفة ضد الباحث، وضد أفكاره، وضد دار سينا، ووقف نصر وراوية ودار سينا وقفة صارمة، ونجحت الدار وصاحبتها ومؤلفها فى وضع بصمة فكرية تنويرية عظيمة نستكملها فى سياق آخر، وكانت الناشرة الملهمة والرائدة راوية عبد العظيم، إحدى بطلات التنوير فى مصر والعالم العربى، ورحلت دون أى وداع يليق بها، ربما تكون تلك السطور القليلة محاولة لرد الاعتبار لها، خاصة أن مجال النشر ليس مجالا ناعما، ولم تتراجع راوية لكونها امرأة، بل خاضت التجربة بكل خشونتها، لكى تصبح ملهمة لأجيال تلتها لسيدات فضليات يكملن طريق راوية عبد العظيم الوعر، ويكملن الدور الذى بدأته دار سينا منذ ثلاثة عقود ونيف.
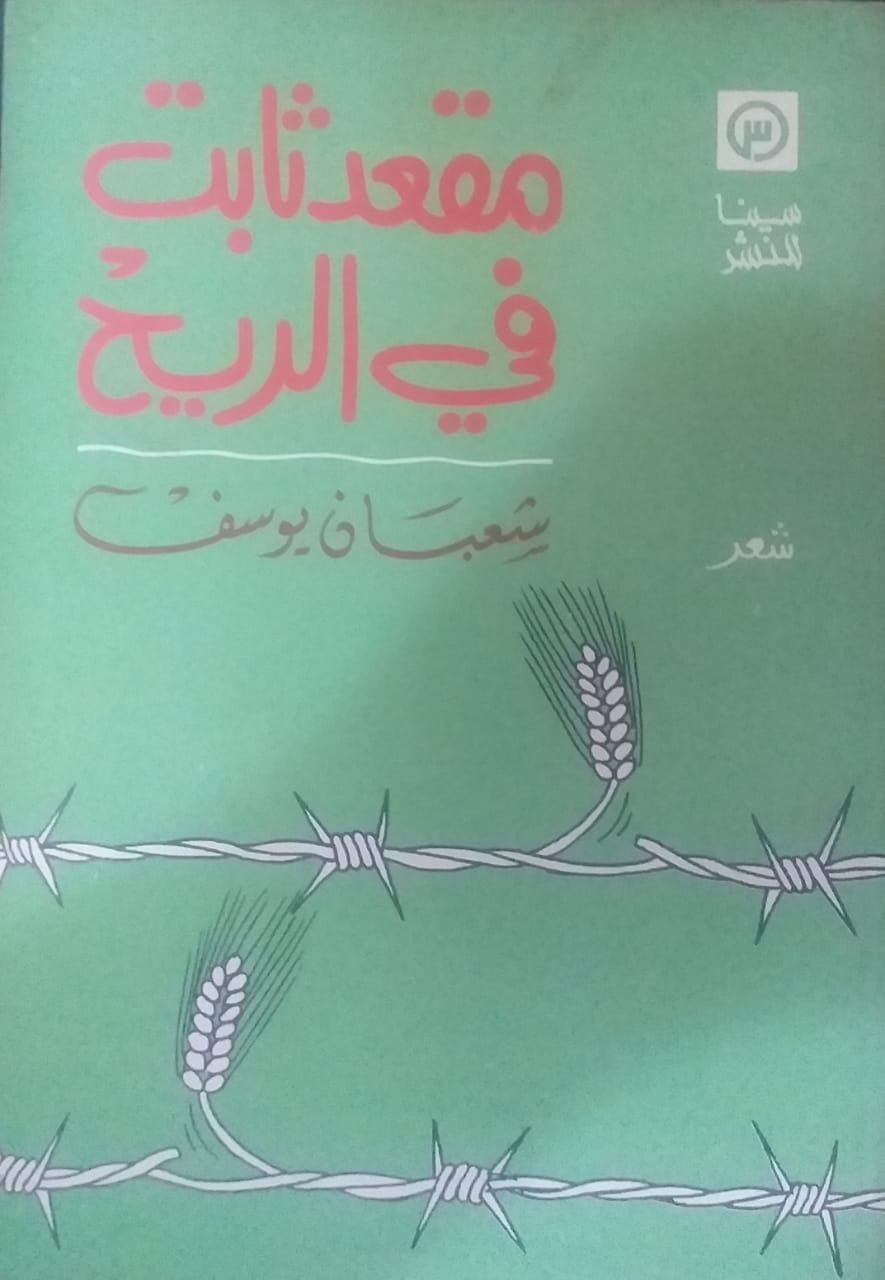





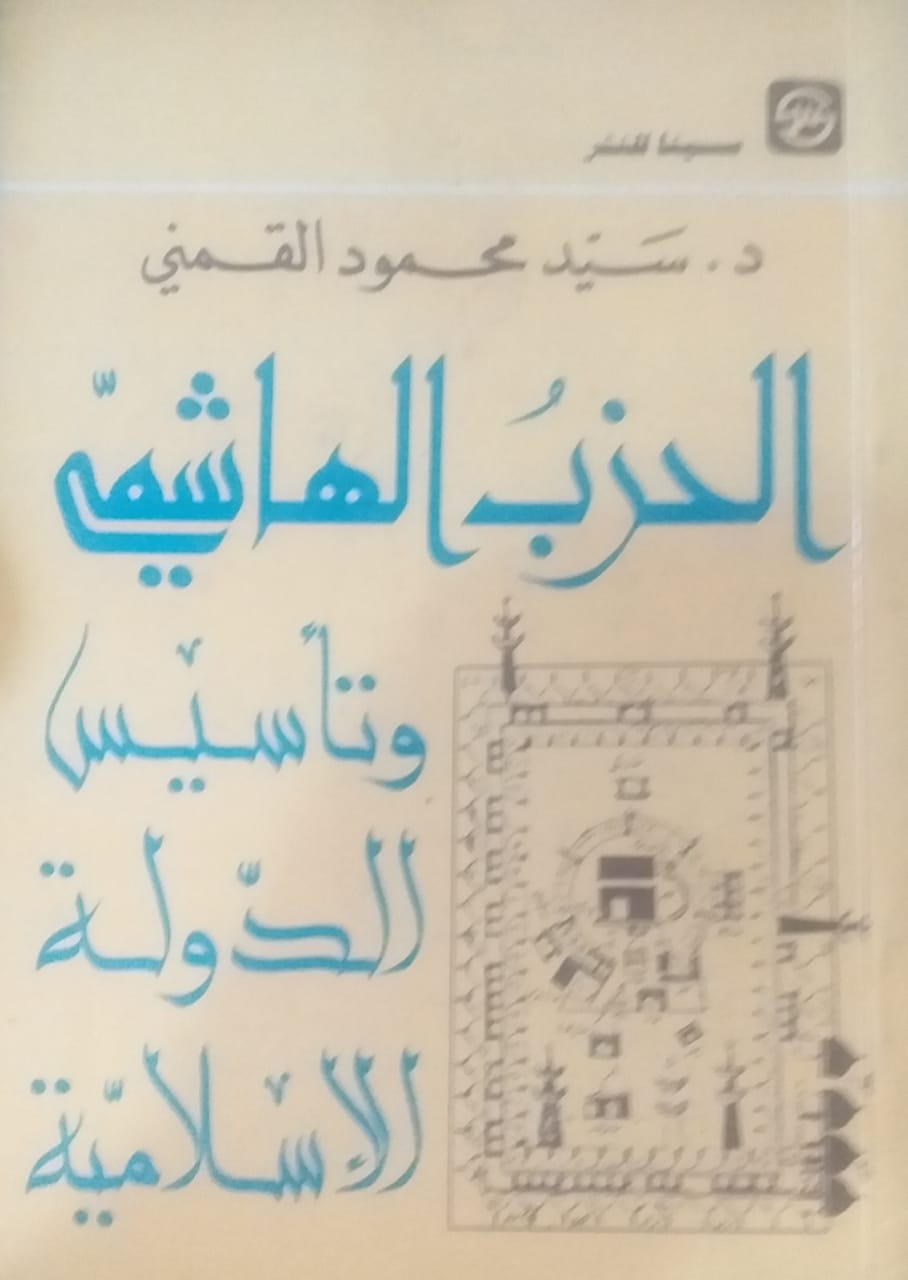


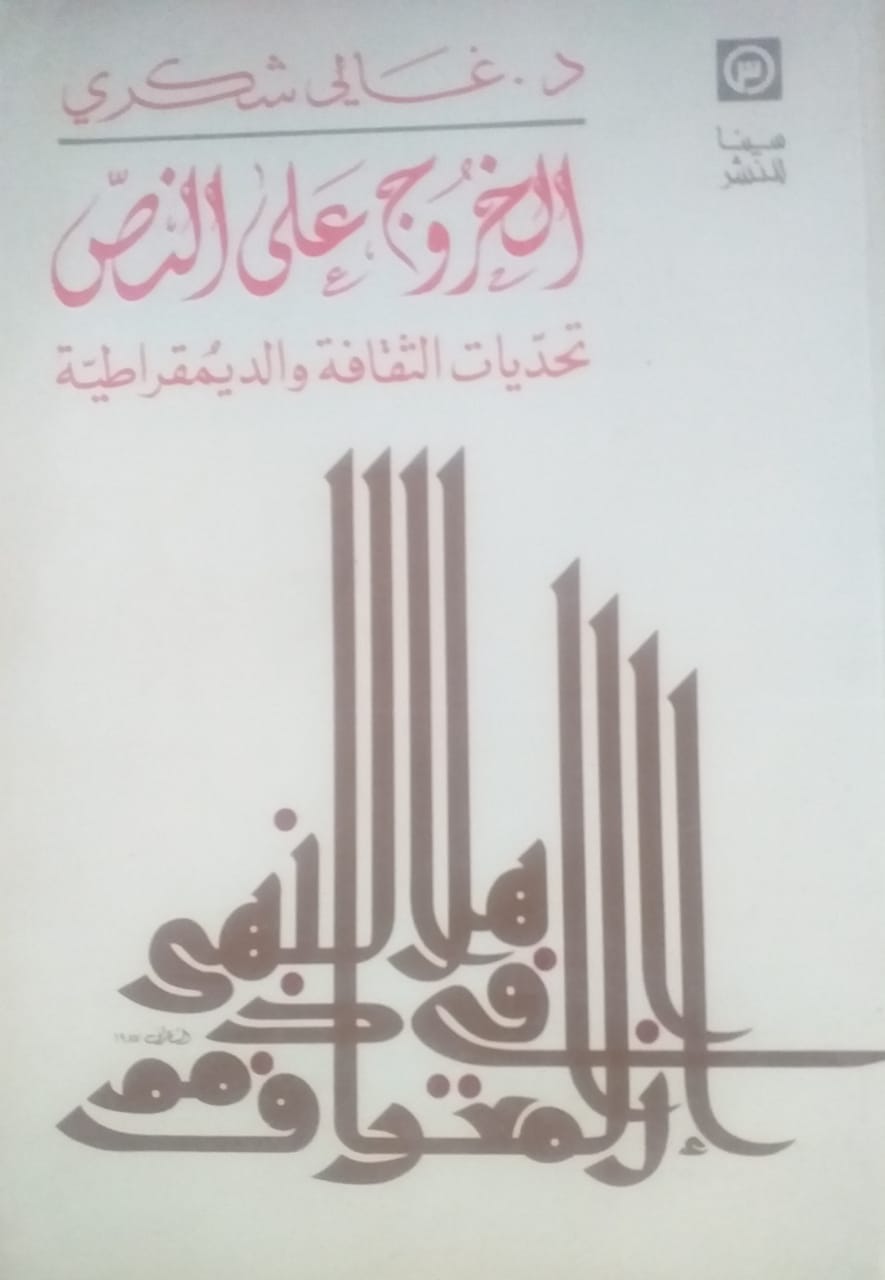


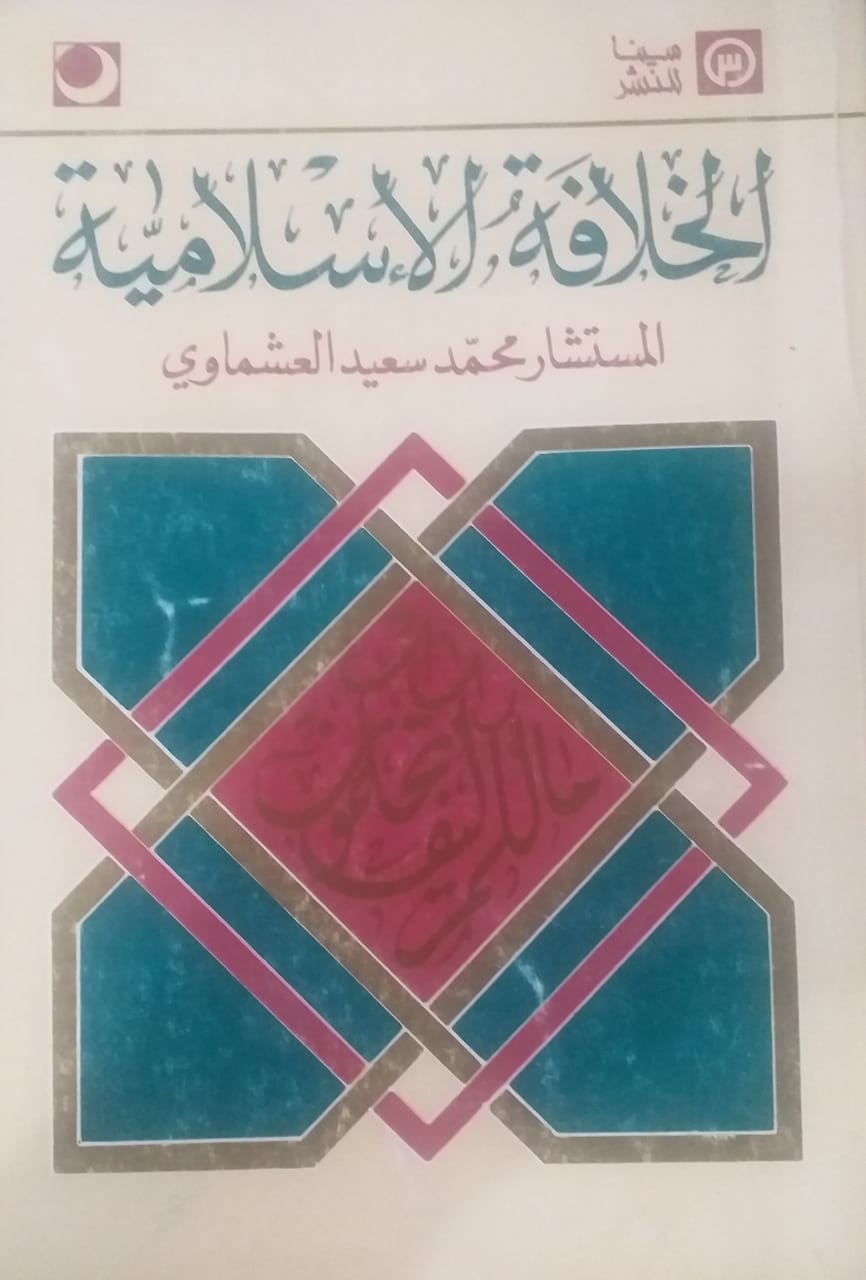

















تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة