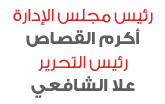ما زلنا مع الحديث عن قراءة التاريخ، فأرجو من القارئ العزيز مراجعة الحلقات السابقة من هذه السلسلة.
يتساءل البعض: كيف بدأت وتطورت كتابة التاريخ؟
لهذا قصة مثيرة، تندرج تحت ما يسميه المشتغلون بعلم التاريخ: «تاريخ التاريخ».
مع قيام الحضارات القديمة العظيمة فى مصر والشام والعراق، اقتصرت كتابة التاريخ على تدوين «أعمال الملوك» فوق جدران المعابد والقبور الملكية والألواح التذكارية، مثل لوح الملك كاموس الذى خلد فيه انتصاره على الهكسوس والمعروض حاليا بمتحف الأقصر، أو الأسطوانات الفخارية، كما فعل ملوك بابل وآشور،
كان التاريخ يمتزج بالأسطورة فى تلك النصوص، فلو زرت معبد الدير البحرى الذى بنته الملكة حتشبسوت فى طيبة / الأقصر، لوجدت جزءا منه مخصصا لسرد قصة بشارة الآلهة لأبيها الملك المحارب تحتمس الأول بولادتها، وأنها ستصبح ملكة عظيمة، وسترى الإله الصانع خنوم يخلقها على عجلة الطين التى يشكل عليها الفخار، ولو زرت تمثال «أبوالهول» فى الجيزة سترى قصة بشارته للملك تحتمس الرابع بتوليه عرش مصر مكافأة له لإزالة الرمال التى كانت تغطى أبوالهول.. وهكذا.
كلن المؤرخ الإغريقى هيرودوت هو أول من فصل التاريخ عن الأساطير فى كتابه «هيستوريا»، وهو لفظ يونانى يعنى طلب المعرفة، فاعتنى بتدوين الأحداث التاريخية الواقعية وشرحها منفصلة عما كان يشوبها من أساطير الآلهة والكائنات الخارقة، ولهذا استحق لقب «أبوالتاريخ».
ظهرت بعد ذلك أساليب متنوعة لكتابة التاريخ، كان منطلق كل منها هو الثقافة التى نشأ فى كنفها والأهداف التى خدمتها،
ففى مصر فى العصر البطلمى، قدم المؤرخ مانيتون مدرسة التقسيم المنظم للعصور والعهود، فى تقسيمه عصور الحضارة المصرية القديمة إلى أُسَر - ثلاثين أسرة - منطلق كل منها موطن نشأته أو مُنطلقها.
وفى العصر القبطى، اهتمت الكتابة بموضوعات مثل تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسير بطاركتها، وسير القديسين والشهداء.
أما الرومان فقد عبّر خطيبهم السياسى شيشرون عن مدرستهم فى كتابة التاريخ، فقال إن الهدف الأول منها هو تقديم المُثُل العليا وبث الحماسة فى الجماهير والناخبين والجنود الرومان.
كانت للثقافة اليهودية القديمة توجهاتها الواضحة كذلك، وهذا بتحويل التاريخ إلى ملحمة بطلها ومحورها هو الشعب اليهودى، بينما تلعب باقى الأطراف أدوار الأشرار أو الأدوار المساعدة أو أن تكون مجرد كومبارس.
وفى أوروبا فى عصر ما بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، وسيادة الكنيسة الكاثوليكية، تحولت كتابة التاريخ - متأثرة بفلسفة القديس أوغسطين - إلى صراع أبدى بين كل من مدينة الرب ومدينة الشيطان، ولم يكن الإنسان سوى أداة بيد أحد الطرفين لخدمة أهدافه، وبقيت تلك الكتابة هى السائدة حتى تراجُع نفوذ الكنيسة وقجوم عصور النهضة ثم التنوير.
ماذا عن العرب؟ للعرب قصتهم الخاصة فى كتابة التاريخ، ففى عصور ما قبل الإسلام تمثلت كتابته إما فى تدوين أعمال ملوك حضارات اليمن القديم - مثل معين وسبأ وحِميَر - أو فى التناقل الشفهى لأشعار مدائح كبار القوم وفرسانهم، والتفاخر بالانتصارات، أو أقوال المهتمين بالأنساب.
أما فى عصور ما بعد الإسلام، فقد بدأت وتطورت الكتابة العربية للتاريخ، بداية من سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وسير الخلفاء، ثم ساهم الانقسام المذهبى بين السنة والشيعة فى سعى كل طرف لتقديم قراءته للتاريخ الإسلامى، وفى العصر العباسى كانت كتابة التاريخ على موعد مع ولادة «التأريخ الوثائقي» على يد الفقيه والمفسر والمؤرخ محمد بن جرير الطبري، الذى ضمّن كتابه الضخم «تاريخ الأمم والملوك» توثيقا للمراسلات والمحادثات والمعاهدات المتعاقبة بكل حدث فى سياق عرضه له.
كان توسع فتوحات العرب وامتداد دولتهم فى رقع من الأرض شهدت حضارات عظيمة مثل مصر والعراق وفينيقيا وفارس وغيرها، دافعا للبحث فى تواريخ هذه الحضارات، صحيح أن الكتابات عنها كثيرا ما شابتها الخرافات المتوارثة والحكايات الخارقة للطبيعة، إلا أنها عكست اهتمام العرب بتواريخ الأمم الماضية وعدم انكفائهم على أنفسهم.
كما ظهر التقسيم المنظم للقترات الزمنية أو ما يُعرَف بـ«الحوليات»، والحَول هو العام، وهو تقسيم الأحداث بطريقة «أحداث العام كذا» وكذلك تقسيمها بعهود الخلفاء والملوك، كذلك ظهرت التخصصات فى الموضوعات، فثمة كتابات تناولت فئات بعينها، كالصحابة، والملوك، والخلفاء، وغيرهم، مثل «أُسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثير، أو «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى، أو «تاريخ الخلفاء» للسيوطى، وكتابات اهتمت بتواريخ المدن والعمران مثل «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزى، أو «معجم البلدان» لياقوت الحموى والذى يجمع بين علمى الجغرافيا والتاريخ، بل وموضوعات أكثر تخصصا ككتابة المقريزى عمن حج من الملوك أو أبو الفرج الأصفهانى عن نهايات الطالبين «نسبة لأبى طالب من بنى هاشم».
لكن درة الكتابة العربية للتاريخ وأكثر تجاربها نضجا قدمها المؤرخ والفقيه والقاضى والسياسى عبدالرحمن بن خلدون فى كتابه «العِبَر وديوان المبتدأ والخبر»، وتحدبدا فى المقدمة العملاقة لهذا الكتاب - حتى أنها تصدر عادة فى كتاب منفصل تحت اسم «مقدمة ابن خلدون» - والتى وضع بها أسس علم التاريخ، من تعريف دقيق، وقواعد منضبطة علميا للاشتغال به، وقواعد لنشأة وقيام وتطور ونهاية المجتمعات والدول وأنظمة الحكم، وقوانين للاجتماع البشرى ونماذجه.
بعد سقوط الحضارة العربية والإسلامية باحتلال العثمانيين للمشرق العربى، وفرضهم حالة من الظلامية والجمود على العلم والفكر، تدهور حال الكتابة التاريخية واحتاجت أن تنتظر حتى نهايات القرن الثامن عشر ليعيد المؤرخ عبدالرحمن الجبرتى إحياءها من خلال كتابه «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»، ثم ليعاد بعث كتابة التاريخ بعد ذلك فى القرن العشرين على أيدى قامات مثل چورچى زيدان وعبدالرحمن الرافعى ومحمد جميل، وغيرهم، ومع سفر الطلاب المصريين لتلقى العلم فى أوروبا ثم عودة الرعيل الأول من الأكاديميين من بعثاتهم وتوليهم التدريس فى الجامعات المصرية الناشئة، عادت كتابة التاريخ لكنها أصبحت متأثرة بالأنظمة الأوروبية ومنها تقسيم التاريخ إلى عصور قديمة ووسطى وحديثة، مثلا.
وللحديث بقية إن شاء الله فى المقال القادم من هذه السلسلة من المقالات.