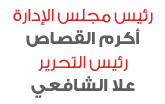الشهادة تطلق فى اللغة على الخبر والمعاينة والعلانية، وتطلق فى اصطلاح الفقهاء على الإخبار بحق للغير على الغير، واشترط الحنفية والمالكية أن يكون هذا الإخبار فى مجلس القضاء، كما اشترط المالكية أن يكون هذا الإخبار بلفظ أشهد، والشهادة أقوى طرق الإثبات فى الحقوق بعد الإقرار، وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على القاضى أن يحكم بمقتضاها إذا اطمأن إليها وكانت مستوفية لشروطها. ومن أهم شروط الشاهد عند الأداء أن يكون متجرداً لا يقصد إلا الحق كما قال تعالى:
«وأقيموا الشهادة لله» (الطلاق: 2)، فلا تقبل شهادة من كان ظاهر الحال يتهمه بالمحاباة أو بالانتقام فى الجملة، والأصل فى ذلك ما أخرجه أبوداود وأحمد بإسناد قوى عن عبدالله بن عمرو، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»، والغمر هو الحقد، والقانع هو الخادم المنقطع للخدمة.
واختلف الفقهاء فى اشتراط صفة الإسلام للشاهد، وما يترتب عليه من حكم قبول شهادة غير المسلم على المسلم فى النزاعات التى يكون أحد أطرافها مسلماً، ويمكن إجمال أقوال الفقهاء فى هذه المسألة فى ثلاثة مذاهب، كما يلى:
المذهب الأول: يرى عدم جواز قبول شهادة غير المسلم على المسلم بحال مطلقاً، سواء فى الوصية فى السفر أو فى غيرها. وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وروى عن زيد بن أسلم والزهرى وقتادة وعطاء، وحجتهم:
1 - أن دلالة النصوص فى الكتاب والسنة مانعة فى ظاهرها من قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين، ومن ذلك قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» (البقرة: 282)، فخرج بذلك رجال غير المسلمين لأن الخطاب للمسلمين، وقوله تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل منكم» (الطلاق: 2)، أى من المسلمين لا من غيرهم.
2 - أن قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» (المائدة: 106) منسوخ بقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» (البقرة: 282)، وعلى التسليم بعدم نسخ الآية فليس المراد بقوله: «أو آخران من غيركم» غير المسلمين، وإنما المراد من غير قبيلتكم أو عشيرتكم.
3 - أن الشهادة تتضمن نوع ولاية، وهى لا تجوز من غير المسلم على المسلم؛ لعموم قوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (النساء: 141).
4 - أن اختلاف الدين أمارة ظاهرة على العداوة وهى تهمة ترد الشهادة، ويدل على تلك العداوة عموم قوله تعالى: «لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» (الممتحنة: 1).
المذهب الثانى: يرى قبول شهادة ويمين غير المسلمين على المسلمين فى الوصية خاصة، وبشرط الحاجة كانعدام وجود المسلمين مع وجود غيرهم، وإلى هذا ذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية ولكنهم قيدوا الحاجة بحال السفر خاصة، وروى هذا عن عائشة وابن عباس وابن مسعود وأبى موسى الأشعرى، وحجتهم: أن دلالة عموم النصوص فى الكتاب والسنة وإن كانت مانعة فى ظاهرها من قبول شهادة غير المسلمين عليهم -كما ثبت فى دليل المذهب الأول- إلا أن القرآن الكريم نص صراحة على جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين فى الوصية فى السفر، فكان هذا كالاستثناء من حكم الأصل، فاقتصر عليه؛ عملاً بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين» (المائدة: 106).
المذهب الثالث: يرى قبول شهادة غير المسلمين مع أيمانهم على المسلمين فى جميع الحقوق الإنسانية عند الحاجة بالضوابط العامة فى الشهود دون أن يكون منها صفة الإسلام، وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم، حيث جاء فى الفتاوى الكبرى لابن تيمية: قال أبوالعباس ابن تيمية فى موضع آخر: «ولو قيل تقبل شهادتهم -أى غير المسلمين- مع أيمانهم فى كل شىء عدم فيه المسلمون لكان وجها، وتكون شهادتهم بدلاً مطلقاً». وجاء فى الطرق الحكمية لابن القيم: «وقول الإمام أحمد فى قبول شهادتهم -أى غير المسلمين- فى هذا الموضع -أى الوصية فى السفر- هو ضرورة يقتضى هذا التعليل قبولها ضرورة حضراً وسفراً.. ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم فى كل شىء عدم فيه المسلمون لكان له وجه، ويكون بدلاً مطلقاً»، وحجة هذا المذهب:
1 - أن النصوص المبينة لصفة عدالة الشهود فى خطاب المسلمين لا تمنع غيرهم من الشهادة عليهم، فقوله تعالى: «شهيدين من رجالكم» (البقرة: 282) وقوله تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل منكم» (الطلاق: 2)، خطاب للغالب وليس تقييداً بصفة الإسلام، وأما العدالة فهى الإنصاف وتكون من المسلم وغير المسلم فى المعاملات دون خصوص العقيدة التى لا تصنف الناس إلى عدل وغير عدل؛ لأن الإسلام جعل اختيار الدين حقاً إنسانياً كما قال تعالى: «لا إكراه فى الدين» (البقرة: 256)، وقال تعالى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف: 29).
2 - قياس الشهادة على اليمين، فإذا صحت اليمين بالله تعالى من غير المسلمين صحت شهادتهم؛ حيث أجاز الشافعية والحنابلة لغير المسلم أن يحلف ويكون حنثه بالإطعام والكسوة دون الصوم، وذلك خلافاً للحنفية والمالكية الذين اشترطوا صفة الإسلام لانعقاد اليمين، لكونها من الديانات. ويدل لصحة اليمين من غير المسلم قوله تعالى: «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين» (المائدة: 106)، وجعل القسم بعد الصلاة لتعظيم اليمين. واختلفوا فى تلك الصلاة فقيل: صلاة العصر لأنه وقت يعظمه أهل الأديان، وهو رواية عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير والنخعى وقتادة وابن سيرين، وقيل: صلاة من صلاة المسلمين، وهو قول الزهرى، وقيل: صلاة أهل دين الشاهدين، وهو رواية عن ابن عباس والنخعى وقتادة.
3 - أن آية المائدة الواردة فى قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين فى الوصية فى السفر تعم الوصية وغيرها من العقود الحياتية، كما تعم السفر والحضر، إذ لا خصوصية فى الوصية، ولا خصوصية فى السفر، وإنما الأمر يرجع إلى الحاجة والمصلحة حتى لا يضيع حق المسلم إذا لم يشهده سوى غير المسلمين.
4 - أن الشهادة إخبار عن أمر وقع، والخبر مقبول من المسلم وغيره بحكم الأصل، وليست الشهادة ولاية وإلا ردت فى شهادة غير المسلم للمسلم. وعلى التسليم بأن الشهادة نوع ولاية فلا مانع أن تكون بين المسلمين وغيرهم كما فى الكفالة والضمان، وأما قوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» فهو متعلق بيوم القيامة؛ لسياق الآية: «فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (النساء: 141).
5 - أن طبيعة اختلاف الدين ترتب تنوعا فى العقائد ولا ترتب عداوة فى المصالح الحياتية؛ لحاجة الناس بعضهم لبعض، ولقوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» (المائدة: 2).
وقد اختار المصريون ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من جواز قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين فى الوصية وغيرها من سائر عقود المعاملات فى ساحة القضاء ومجالس التحكيم الأهلية؛ لتصالح المصريين مع أنفسهم وتعاونهم فى سبل المكاسب والإعمار، وأنهم لا يجدون أثراً سلبياً على مصالح حياتهم المشتركة بسبب اختلاف الدين وتنوع المذاهب والعقائد، ولذلك نص قانون الإثبات المصرى فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968م فى المادة «64» على أنه: «لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمسا وعشرين سنة»، وفى المادة «82» على أنه: «لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز»، كما تنص المادة «86»: «على الشاهد أن يحلف يمينا أن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك»، وهذا اعتراف صريح بقبول الشهادة واليمين من غير المسلمين، وقد جرى العمل فى مصر على ذلك دون أى معارضة فكان كالإجماع على اختيار المصريين لقول ابن تيمية وابن القيم فى قبول شهادة غير المسلمين وأيمانهم فى الحقوق الإنسانية.
وترك المصريون مذهب جماهير الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين، وإن استثنى الحنابلة والظاهرية عقد الوصية فى السفر أو عند الحاجة؛ لما فى مذهب الجمهور هنا من غرابة تحول دون التعاون الإنسانى على المصالح المشتركة؛ امتثالاً لقوله سبحانه: «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى» (المائدة: 2)، إن المصريين قد تذوقوا معنى الفقه وأدركوا أنه صناعة بشرية تصيب وتخطئ فاختاروا منه ما يدرأ عنهم المفاسد وما يجلب لهم المصالح؛ عملاً بما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن وابصة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
«استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»، وأخرجه عن أبى ثعلبة الخشنى بإسناد جيد بلفظ: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون».

-
موعد مباراة نهائى كأس السوبر الإسباني بين برشلونة ضد ريال مدريد
-
ريال مدريد يهزم ريال مايوركا بثلاثية ويواجه برشلونة فى نهائى السوبر الإسباني
-
Watch it تكشف عن الصور الأولى من مسلسل الشرنقة وعرضه فى رمضان 2025
-
الريال ضد ريال مايوركا.. شوط أول سلبي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني
-
صفحة اليوم السابع على فيس بوك تتجاوز 29 مليون متابع
-
الأهلي يعلن إجراء ناجحة لـ يحيى عطية الله لتثبيت كسر مضاعف في الوجه
-
رونالدو يصل للعام الـ24 متتالى تسجيلا للأهداف فى فوز النصر علي الأخدود
-
فيديو.. شاهد استمرار عمليات إطفاء حريق أعلي عقار بسوق التوفيقية
-
أول رد من مجدى عبد الغنى بعد أزمة ضبطه بسيارة بدون لوحات معدنية
-
الطقس غدا.. تفاصيل حالة الجو بجميع الأنحاء.. ودرجات الحرارة على واحدة وصفر