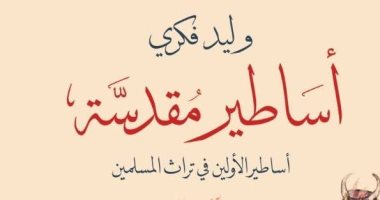تمر اليوم ذكرى رحيل عميد الأدب العربى طه حسين، الذى رحل يوم 28 أكتوبر 1973، تاركاً خلفه إرثاً عظيماً من الأفكار الساكنة فى الكتب والمقالات، ومن ذلك ما نشر فى كتاب مهم بعنوان "طه حسين: الأوراق المجهولة - مخطوطات طه حسين الفرنسية"، كان قد صدرت ترجمته عن المركز القومى للترجمة وترجم هذه الوثائق عبد الرشيد محمودى، مقالة بعنوان "قوة القرآن من الناحية الصوفية منشورة لغير المسلمين" كلام جميل من عميد الأدب العربى، ننقل جزءا منه يقول فيها:
المسلم الذى تضلع فى معرفة المأثورات الإسلامية وتربى فى وسط بلغ فيه تقديس جمال القرآن طورا متقدما يتعرض لتأثير هذا الكتاب الشهير إلى حد وبقوة لا يعدلهما شىء آخر فى هذا العالم، فالقرآن يضع المسلمين الذين تشبعوا به فى حالة من النشوة فريدة تماما، إذ يشعر المرء عند الاستماع إليه بأنه يرقى إلى مستوى يعلوه، وينفتح أمامه عالم جديد، وتستولى عليه سعادة صوفية، غبطة من طبيعة المتعة الروحية. وباستطاعتنا لكى نكون فكرة عنها أن نتذكر ما لا بد لكبار الموسيقيين أن يشعروا به فى أسمى لحظاتهم. وتأثير القرآن على المسلمين ذو طابع معجز والمعجزة من الوضوح بحيث لا نحتاج إلى تحليلها، فالمعجزة تكتنفنا بسرها العميق وتمس نفوسنا بعمق عميق بحيث نسلم بأن طبيعتها قريبة شديدة القرب من سر النفس الأعظم ومن الله، ولم يحدث قط أن كان لعمل أدبى تلك السيطرة التى مارسها القرآن على القادرين على تقدير قوته.
ومن سوء الحظ أن الأوروبيين، مثلهم مثل الهندوس واليابانيين فيما أعتقد، لا يدركون فى القرآن شيئا من ذلك. وقد يكون من الصحيح أن يقال إنهم صم عن جمال القرآن كما يكون المرء أصم عن الموسيقى، ولكن ذلك لا يتقدم بنا فى البحث كثيرا.
وبناء على ذلك اضطلعت بهذه الدراسة الموضوعية للكتاب العظيم بغية أن أشرح لغير المسلمين تأثير القرآن الفريد؛ بل وقد يكون من الأفضل أن أقول لغير العرب بدلا من أقول لغير المسلمين لأن العرب، بما فى ذلك المسيحيون أنفسهم، معرضون لهذا التأثير. وكان على أن أتخلى للحظة عن عواطفى كمسلم لأننى لا أسعى إلا لدراسة ظاهرة ذات طابع أدبى.
ولنبدأ بالوقائع:
رجل عمره أربعون سنة أمضى حياته فى مكة فى سلام واعتدال وبكثير من التميز. كان شديد الانضباط، فحرص على الامتثال للعرف القائم ولم يسمح بالظهور لأى عرض من أعراض حركته الثورية القادمة. وهو حتى ذلك الحين لم ينبس قط بكلمة تشبه القرآن. والقرآن يذكر بهذه الحقيقة. ثم يشعر الرجل على نحو فجائى تماما برغبة لا تقاوم فى الرحيل عن مكة وقضاء بعض الوقت فى الصحراء، فى عزلة غار. وهو فى وحدته يتفكر معذب النفس وتغزو قلبه مشاعر بغير نظام. وهو يسعى مضطرب النفس إلى أن يخضع لنظام فوضى أحاسيس جديدة لا عهد له بها.
كانت الصحراء الممتدة إلى أقصى مدى تحيط به، فلا بد أنه وجد فى هذا الفضاء الرحب - فى السكون النابض الذى لا تتيحه إلا الصحراء وفى هدوء الليالى المرحبة فى تلك المناطق - راحة وسلوى من آلام روحه. ونظرا لأنه لم تتح له الفرصة قط لكى يضع هذه الخبرات فى شكل معروف، فقد كان يشقيه افتقاره هذا إلى الوسائل اللازمة ِلإضفاء شكل مناسب على مشاعره إما عن طريق العمل، أو عن طريق الكلام. وذلك شقاء مفهوم يعرفه كثير من الأشخاص فى لحظات أقل إثارة للقلق.
وذات مساء أصبح الأمر يفوق طاقته. كان مرهقا ووجد نفسه فى حالة من النشوة عذبته بفظاعة. ووجد نفسه فجأة ينطق بألفاظ عربية غريبة ومفهومة وإن لم تكن تشبه شيئا مما قاله أو سمعه يقال حتى يومه ذاك. والغريب فى الأمر أنه يستشعر الخوف من هذه الألفاظ التى ينطق بها هو نفسه. وهو لا يدرى ماذا عساه يفعل فى حضرة هذا اِلوحى. والأثر الناتج هنا عنيف لا يقاوم وساحق كما هو الحال فى جميع اكتشافات الحقائق العظمى. وهو يستشعر فى هذه الألفاظ صفة خاصة، وهو رغم اتصال خوفه يخضع لتأثيرها الغامض. وكان فى حاجة إلى قضاء بعض الوقت لكى يستعيد قدرته على الحكم الواضح (وهى قدرة كان فخورا بها) ولكى يقدر قيمة اكتشافه حق قدرها. وهو يتلو هذه الآيات القليلة على زوجه فتجدها بدورها رائعة.
وهى تشجعه على تصديقها لأنها أكثر منه ثقة. وشيئا فشيئا تتراكم الكلمات ويشتد أسرها. ويجد محمد فى نهاية المطاف الشجاعة على ترديدها سرا على مسامع بعض الأصدقاء الذين يتبين أنهم مقتنعون بهذه العبارات البسيطة دون أن يخامرهم فيها رأى آخر. بل أن الأشخاص الذين كان من شأنهم أن يروا فى هذه المفاهيم الجديدة ما يضر بمصالحهم لم ينجوا من التأثير المعجز.
وتقع أشياء لا تصدق. فثمة عربى بدوى على صهوة حصانه أو على ظهر جمله يسمع بالمصادفة بعض آيات القرآن؛ فيتوقف ويجد الشخص الذى يتفوه بهذه العبارات الجذابة، فيعاهده على الوفاء ويضع حياته تحت تصرفه. ويشمل البلاد تيار من الحماس. ورغم أن السكان كانوا رحلا متفرقين ويقيمون ما زالوا على المثل العليا للأجناس البدائية، فقد ألفوا فى بضع سنوات أمة قوية تحت راية القرآن لها مثل أعلى. فقد وحد القرآن بينهم لأنهم كانوا مجمعين على حقيقة واحدة، هى الطابع الإلهى للقرآن.
هذه الوقائع لا تقبل الشك. ولكن سعى البعض إلى التقليل من أهميتها بالاستناد إلى حالة العرب البدائية. وادعى البعض أن إبهار سكان الصحراء القاحلة البسطاء هؤلاء لم يكن يقتضى الشيء الكثير. وهو موقف يسهل فهمه فى حالة علماء القرن التاسع عشر، ولكن عفى عليه الزمن. فهؤلاء العلماء الذين أسكرتهم مكتشفاتهم الجديدة كانوا ذوى أحكام قاطعة فيما يتعلق بجميع الظواهر. فهنالك محور الخط المستقيم، والطابع النهائى للقوانين، لقانون الجاذبية، وقانون حفظ الطاقة، والضوء، ولا تناهى الكون، ومعرفة الأشياء التى تخرج عن نطاق الزمان، والفلسفة الثابتة، والفصل بين الطبقات والأجناس. أما اليوم فقد تغير كل ذلك. وذلك أن عصرنا هو عصر نسبية المنحنيات فى المكان، عصر الكون المتناهى والمتزايد عظما. بل لقد أصبح هناك اعتراف بالغائية فى الظواهر الطبيعية مثل النشاط الإشعاعى؛ ذلك هو عصر فلسفة الحركة والزمان والتغير منظورا إليها بوصفها جوهر الأشياء المادية ذاته. ولم يعد هناك ما يمكن تأكيده على نحو قاطع. والعلماء الأوروبيون متقدمون بمقدار نصف قرن على الأقل على معاصريهم من رجال السياسة، والمال، والنقاد وغيرهم. فقد أثبتوا على نحو نهائى أن الناس في أعماقهم متشابهون على نحو مهين للمتحذلقين. وقضى علماء التحليل النفسى بالضربة القاضية على كل فكرة تقول بالتفوق الفطرى لبعض الأفراد أو بعض الأمم. وقوة الشعور الباطن صارت أمرا مسلما به، وهى متماثلة تقريبا لدى جميع البشر.
ثم إن الظاهرة تكون عظيمة بقدر اتساع نطاقها. وليس من المهم الوقت أو المكان الذى وقعت فيه. ومن الغريب أن نلاحظ أن بعض الناس الذين أضنوا أنفسهم بحثا عن تفسير لمغزى ظاهرة قليلة الشأن مثل التكعيبية يجهلون أو يتجاهلون ظاهرة فريدة وهائلة مثل تأثير القرآن على الملايين والملايين من البشر.
ولدينا إذن كل الحق فى معاملة هذه الظاهرة بوصفها من أعجب ظواهر التاريخ، ولا سيما أن أداة هذه الحركة التى نشأت بين الأميين عمل أدبى، وهو ما يزيد نجاحها غرابة على غرابة.
والموضوع الرئيسى فى جميع الكتب المقدسة هو حث الناس على فعل الخير والامتناع عن الشر. وليس هناك ما هو أسهل من إلقاء مواعظ من هذا النوع. ولكن يختلف عن ذلك تماما التأثير على الناس والارتقاء بهم مما يجعلهم يعيشون وفقا لقواعد ضمائرهم، وحملهم على قبول التضحيات اللازمة. وإذا كان هؤلاء الناس ينتمون لجنس بدائى ومترحل ولا عهد لهم بممارسة الأفكار المجردة، فإن دمجهم فى أقل من ثلاثين سنة فى أمة قوية وموحدة تخرج إلى غزو الإمبراطوريات الكبرى المجاوزة بغية هدف واحد هو حملهم على الإيمان بإله واحد يبدو أمرا معجزا. وهولاء العرب الشجعان لم يتساءلوا قط عن أعداد الجيوش التى يتعين عليهم مواجهتها ولا عن مدى قوتها. كان المقاتل العربى يرفع فى غمار المعركة سيفه لهزيمة خصمه ولم يكن هذا الأخير مطالبا بشيء سوى أن يقول: "لا إله إلا الله"، وكان العربى يلقى بسيفه لكى يعانق رفيقه الجديد. ومثل هذه الوقائع تثبت أن هؤلاء العرب كانوا فى حالة من النشوة والجموح لا تصدر إلا عن مثل أعلى شديد السمو. وليس هناك ما يستعصى على المقاومة مثل رجل عمل تتملكه فكرة مجردة يكرس لها كل طاقته.