تُرى، لو قُيِّضَ للراحلين مِن مشاهير فنانينا الرواد أن يعودوا للحياة، لِيَطَّلِعوا على بعض ما كُتِب عن أعمالهم وأساليبهم، من تفسيراتٍ وتحليلات، حَصَرَتها في خاناتٍ معينة من التأويلات، ودَمَغَتها بطابعٍ محدد من التوصيف والتصنيف، فهل تراهم يُقِرّون ذلك ويوافقون عليه؟ وماذا لو خرجوا هم أنفسهم علينا بآراء مضادة، تتعارض مع ما استقرّ في مخيلتنا عن فنهم، وتختلف عما اعتدنا أن نتداوله من تصنيفات لتَوَجُّهاتِهم الإبداعية ومُنطَلَقاتِهم الفكرية؟
أسئلةٌ دارت في ذهني، خلال انشغالي بإنهاء هذا المقال، الذي سأكشف من خلاله عن نَصٍّ مجهولٍ بالغ الأهمية، نشرَه أحد أفذاذ فنانينا الرواد، منذ ما يزيد على سبعين عاماً، ظل خلالها طَيّ النسيان، ولم يُعنَ بِرَصدِه أو تحليله أو بإعادة نشرِه، في أيٍّ من الكتب والدراسات التي تناولت حياة هذا الرائد وفنه.
والنَصّ الذي نحتَفي به اليوم يحمل مِن الآراء والتفاسير، التي أورَدَها هذا الفنان الفَذّ، حول طبيعة الفن الحديث، وحول رؤيته للفن المصري في عصرِه، بل ومِن تنَبّؤاتِه المستقبلية لما سيكون عليه حال الفن العالمي، ما يتعارض جملةً وتفصيلاً، مع كثرةٍ من الآراء النقدية التي استقرّت لدينا حول هذا الفنان وحول أعماله، والتي صارت في حُكم المُسَلَّمات البديهية، التي تُستَدعى بمجرد سماع اسمِه.
ذاك هو الفنان المصري الرائد "محمود سعيد" (1897 – 1964)، الذي تزامَن عثوري على نَصِّه، المُشار إليه آنِفاً، مع وقائع الكشف عن عملٍ مجهولٍ له، ظل موجوداً ضِمن مقتنيات "بيت الكريتلية" (متحف جاير آندرسون) بالقاهرة، إلى أن تم إلقاء الضوء عليه وتوثيقه، من خلال لجنة رسمية شَرُفتُ برئاستها، وتم نشر تفاصيل هذا الكشف في مقالٍ سابق على موقع "اليوم السابع"، تحت عنوان "محمود سعيد في بيت الكريتلية".
نعود الآن للنَصّ المُحتَفى به في مقالنا الحالي، وهو عبارة عن حديثٍ كان "محمود سعيد" قد أدلى به، في مناسبةٍ جمعَته ببعض رجال الفكر والفن والقلم عام 1948، ثم طُلِبَ منه أن يصوغَه في مقالٍ يُلَخِّص فيه أهم أفكاره. وقد نُشِرَت هذه الخلاصة خلال العام نفسِه، في الكتاب التذكاري لجريدة "البصير" السَكَندَريّة في عيدها الذهبي.
وقد طُبَع هذا الكتاب التذكاري النادر طبعة محدودة؛ إذ طُبَعَت منه نسخة واحدة على ورق "واتمان"، وطُبِعَت خمس عشرة نسخة على ورق خاص، مرقومة من "أ" إلى "س"، إضافةً لخمسمائة نسخة على ورق ممتاز، مرقومة من 1 إلى 500. وقد عَثَرتُ على واحدة من هذه النُسَخ الخمسمائة، في أثناء بحثي حول وثائق تتعلق بحركة النشر الفني خلال النصف الأول من القرن العشرين، وذلك بالتزامُن مع أعمال لجنة متحف "جاير آندرسون"، كما مَرّ آنِفاً.
ونَصّ "محمود سعيد" منشور في الكتاب من صفحة 43 إلى صفحة 45، ومُزَوَّد برسمَين توضيحيَّين، في افتتاحه وختامه، من أعمال "نقولا جرجس"، أحد رسامي جريدة "البصير" المشار إليها سابقاً، بالإضافة لصور فوتوغرافية شارحة، استعان بها "محمود سعيد" لتوضيح رأيه في بعض الأعمال الفطرية التي أنتجها أطفالٌ مصريون موهوبون.
ويَحسُن، قبل الشروع في التعليق على حديث "محمود سعيد"، وإيراد نَصّه بالكامل، أن نَسوقَ شيئاً من المعلومات حول جريدة "البصير"، التي استأثَر كتابُها التذكاري بنشر هذا المقال النادر الذي وَثَّق آراء ذلك الفنان الفَذّ.
تاَسَّسَت جريدة "البصير" على يد "رشيد شمَيِّل" بك، وهو ينتمي إلى عائلة لبنانية ذات باع كبير في ميدان الصحافة والفكر، تعود أصولها إلى قرية "كفر شيما" بجبل لبنان، وهي العائلة التي برز من أبنائها الطبيب الأديب المفكر "شِبلي شمَيِّل".
.jpg)
البصير
وكان "رشيد شمَيِّل" صديقاً لـ"بشارة تقلا"، وعمل خلال فترة من حياته مراسلاً لجريدة "الأهرام" في القاهرة، كما تولى إدارة "الأهرام" بالإسكندرية، وكان أسلوبه يتميز بالبساطة؛ استهدافاً لمخاطبة عموم الناس. وكان هدف "شمَيِّل" من تأسيس "البصير" هو إيجاد لسان حال للإسكندرية، يوائم مطالب أهلها ويلائم بيئتها ويغطي أخبارها.
وصدر العدد الأول من "البصير" في الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر عام 1897. وقد جذبت الجريدة نخبة من ألمع الأقلام وقتها، كان من بينهم – بخلاف الكُتّاب من أفراد عائلة "شمَيِّل" – كلٌّ من: الشيخ "أمين الحداد"، و"عبده بدران"، و"طانيوس عبده"، و"إلياس فياض"، و"نجيب هاشم"، و(الصحفي العجوز) "توفيق حبيب".

واستمر صدور "البصير" بانتظام قرابة ستين عاماً، اتخَذَت خلالها طابعاً اقتصادياً سياسياً؛ إذ كانت أهم موضوعاتها تُنشَر حول شؤون التجارة والسياسة، فضلاً عن شؤون القضاء المُختَلَط؛ إلى الحد الذي جعل منها صحيفةً معتمَدة لدى المحاكم المختلَطة، تُنشَر فيها إعلاناتها وأخبارها وإنذاراتها. غير أنها، من ناحيةٍ أخرى، لم تُهمِل مجالات الفنون والأدب والفكر، بل أولَتها عنايةً كبيرة، واستَكتَبَت في موضوعاتها نخبة من مشاهير المتخصصين وقتَئِذٍ. وظل هذا دأب جريدة "البصير" حتى توقفها عن الصدور في نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي.
وحين شَرَعَت إدارة "البصير" في نشر كتابها التذكاري، احتفالاً باليوبيل الذهبي للجريدة، اختارَت لتحريرِه نخبة من الشخصيات البارزة والأقلام اللامعة آنذاك، من بينهم: شاعر القُطرين "خليل مطران"، و"محمد عبد الخالق حسونة" باشا، محافظ الإسكندرية وقتها، والشيخ "حسنين محمد مخلوف"، مفتي الديار المصرية، و"محمد صادق جوهر" بك، مدير "جامعة فاروق" (جامعة الإسكندرية حالياً)، والرائدة النسائية "درية شفيق"، والدكتور "حافظ عفيفي" باشا، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس الأمن الدولي لعام 1946 ووزير مصر المفوّض في بريطانيا سابقاً، والرأسمالي الشهير "محمد فرغلي" باشا، والمعمار الفَذّ "مصطفى فهمي باشا"، مدير بلدية الإسكندرية وكبير مهندسي القصور الملكية، والمؤرخ الدكتور "عزيز سوريال"، و"أنطون خوري"، مدير شركة "نحّاس فيلم"، والخطاط البديع "محمد إبراهيم"، بالإضافة للفنان الرائد "محمود سعيد"، لتستكمل بذلك تمثيل أركان مجالات الفكر والإبداع والحراك الاجتماعي والسياسي في مصر آنذاك.
.jpg)
البصير
وقبل أن أسوقَ نَصّ "محمود سعيد" بتَمامِه، كما ورد بالكتاب، سأكتفي في هذا المقام بأن أُسَجِّل بضعة ملحوظات سريعة، تاركاً للقارئ الكريم مهمة استيفاء التأمُّل في هذا المقال المهم، الذي يُفَنِّد كثيراً من التأويلات الشائعة، المرتبطة بِفَنّ "محمود سعيد" في أذهان كثرة من المَعنيّين بالفن المصري الحديث ودارسيه والباحثين في شأنِه.
وأولى الملحوظات أننا نجد "محمود سعيد" يَستَهِلُّ نَصّه بما يفيد انتباهَه إلى تأثُّر المتحدثين عن الفن المصري الحديث بالدراسات الحضارية وبالنظريات الفنية المستحدثة، بما يؤدي إلى صعوبة في تحديد كُنه هذا الفن المصري الحديث. وتلك ولا شك ملحوظة تكشف، من ناحية، عن مدى عُمق إحاطة "محمود سعيد" بقضية تحديد الهوية الفنية الحديثة – بمقاييس تلك الفترة – كما يكشف، من ناحية أخرى عن أن إشكالية تعريف مفهوم (الحداثة) الفنية – والتي لا تزال مجالاً للنزاع حتى الآن بين بعض المشتغلين بالنقد مَحَلّيّاً – كانت مَحَل اهتمام رواد بقامة "سعيد" منذ ما يزيد على سبعين عاماً.
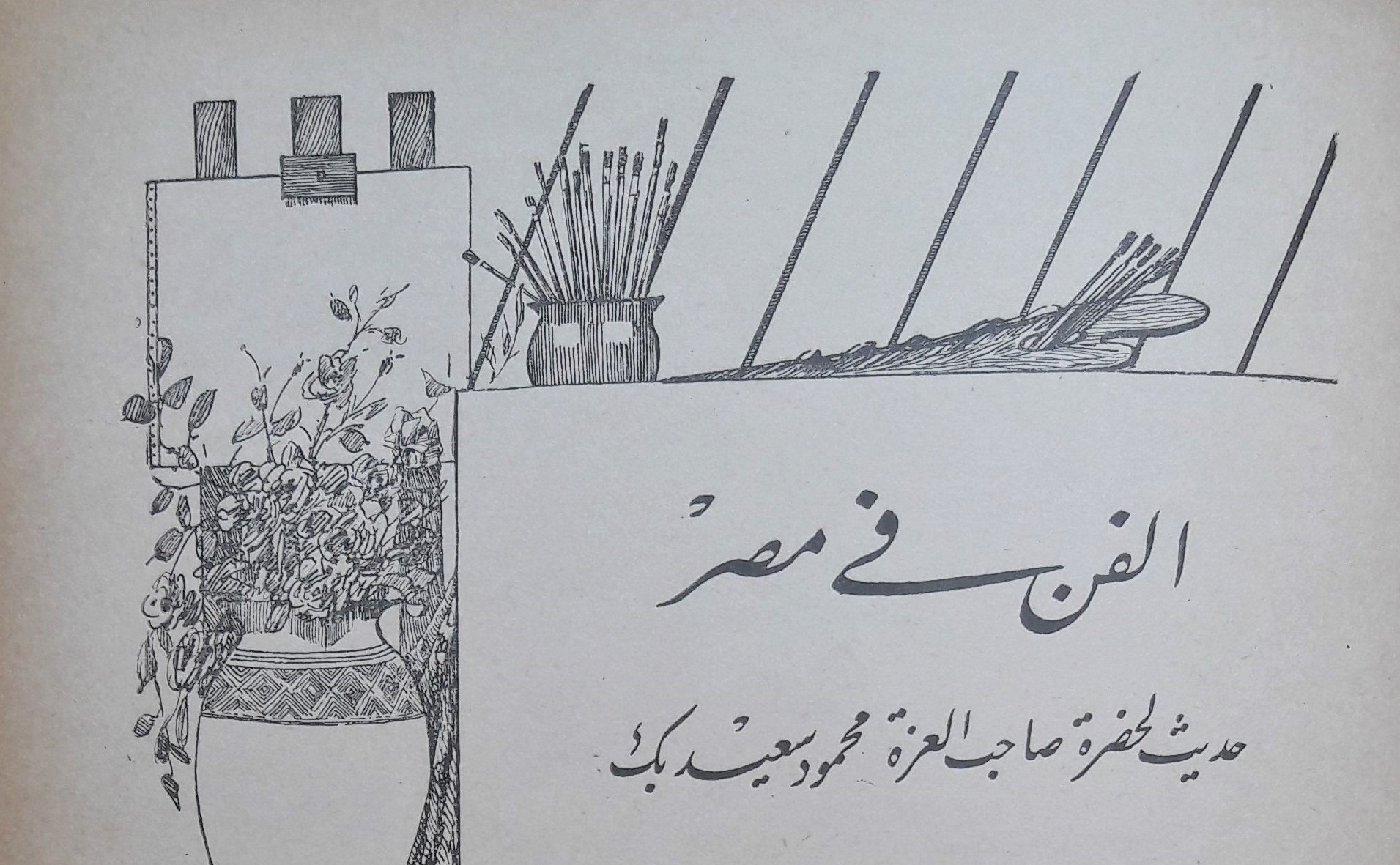
الفن فى مصر
الملحوظة الثانية - وهي مفاجأة بِحَدّ ذاتها - تتمثل في أن "محمود سعيد"، الذي يُصَنَّف مِن قِبَل كثرة من الأقلام بِوَصفِه (فناناً قومياً)، يُصَرّح في نَصِّه ببساطة بصعوبة تأطير الفن الحديث في سياق قومي محدد، باستثناء الهوية المشتركة للفطرة الإنسانية ذاتها؛ لأن الفن في رأيه (لا وطن له)!
وتكشف الملحوظة الثالثة عن مدى الاستشراف المستقبَلي الخارق، الذي كان يتمتع به "محمود سعيد"؛ وذاك إذ يتنبأ في نَصِّه بما نسميه الآن بـ(العولمة)! حيث قال باتجاه الثقافة العالمية نحو صبغة عالمية واحدة. وفي سياق ذلك، نراه يحدد تعريفاً عبقرياً للفن المعاصر، بمفهومه الراهن، حين ينسِبه إلى (الزمن) لا إلى هوية ثقافية محددة.
أما الملحوظة الرابعة فتكشف عن أن "محمود سعيد" كان راصداً يَقِظاً لتحولات الأساليب الفنية في زمنِه، واتجاهها من الأكاديمية للتحرر الفطري آنذاك.
ونتوقف في الملحوظة الخامسة عند تصريحه بأن الفن – بحسب رأيه - لا يُلَقَّن في المعاهد، التي لا تقدم سوى الإلمام بتاريخ الفن، وقواعد الجماليات – "علم الجمال" (الاستطيقا)، وقد ساقها باللفظ الفرنسي (استيتيك) – فضلاً عن التمكن من قواعد الأداء (تكنولوجيا الفن)، التي كتبها على هذا النحو: (تكنيلوجيا). كما أنه يفرِّق بين قواعد الأداء وأصول الصنعة وبين حرية التعبير وانطلاق الأسلوب.
وتتعلق الملحوظة السادسة برأيٍ صادم، أعلنه "محمود سعيد" في سياق النَصّ حول الفن المصري الحديث؛ إذ برغم مرور حوالي أربعين عاماً على انطلاق جيل الرعيل الأول، وقت نشر المقال، فإنه يعتبر أن الفن المصري الحديث لا يزال في طور التكوين، وبالتالي فإن الحديث عنه حديث عن (غير موضوع) إلا على سبيل التأريخ!
ثم نتأمل من خلال الملحوظة السابعة شيئاً من التذَبذُب في إلمام "سعيد" بتاريخ الفن المصري؛ وذلك حين نراه يؤرخ لتأسيس مدرسة الفنون الجميلة القاهرية بعام 1907 – والصواب عام 1908 - كما يؤرخ لنشأة السريالية المصرية بعامَي 1938 و1936 دون تحديد. غير أننا نراه، في المقابل، يسجل ملحوظة تكشف عن نفاذ بصيرة؛ حين يقرر أن بعض الأساتذة القدامى، مثل "رمبرانت"، و"إل جريكو"، و"جيوفاني بليني"، كانت بعض أعمالهم تنطوي على ملمح سريالي، برغم ظهور المصطلح بعد ذلك بقرون طويلة. وهو بذلك يُثبِت عُمق إدراكه لجوهر تجارب أساطين الفن العالمي، خارج الإطار الحديدي للتصنيفات المدرسية الشائعة.
ومن الجوانب التأريخية المهمة في نَصّ "محمود سعيد"، أنه يرصد أسماء الفنانين المستقلين في مصر، مِمَّن كَوّنوا أساليبَهم خارج نطاق الأكاديمية. كما أنه يرصد تجربة الفنان المُعَلِّم "حبيب جورجي" التربوية في تعليم الفن، ويعتبرها بداية للفن المصري (الحقيقي)؛ لاعتمادها على الفطرة وابتعادها عن تأثيرات الفن الغربي والقواعد الأكاديمية.
ويقرر "محمود سعيد" في مقاله أن شرط الأستاذية هو شخصية الفنان المتفردة العبقرية، لا الاشتغال بتعليم الفنون، وأن هذه الأستاذية هي ما تحتاجه مصر لتحديد قيمة الإبداع فيها. كما نراه يَسوق رأياً مستنيراً، حين يصرح بأن الفنانين الأجانب المقيمين بالإسكندرية سَكَندَرِيّون بحُكم الاستيطان والامتزاج الثقافي.
ويشير "سعيد" في خاتمة نَصّ حديثِه للصلة بين ازدهار الفنون وبين الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويفسر عدم تكوين حركة فنية واضحة المعالم – من وجهة نظره – بغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر خلال العقود الأولى من القرن العشرين.
أما الملحوظة الأخيرة على النَصّ، فتتمثل في أن "محمود سعيد" بدا متأثراً بوضوح بثقافته الفرنسية عند ذكر أسماء الفنانين؛ حيث يُورِد أحياناً اسم العائلة أو اللقب قبل اسم الفنان؛ على شاكلة: "فرج منصور"، عند حديثه عن النحات "منصور فرج". كما أنه يهمل استعمال (ال) التعريف في ألقاب فنانين آخرين؛ كما في حديثه عن "عفيفي" أي "يوسف العفيفي"، و"صدر" أي "سعيد الصدر". كما أنه يورِد مصطلحات الفنون بمَنطوقها الفرنسي، مكتوبةً بحروف عربية؛ فبالإضافة للألفاظ التي مَرّت بنا سابقاً، مثل (استيتيك) و(تكنيلوجيا)، نراه يستخدم كلمات (امبريسيونسم)، و"سورياليزم"، و"سورياليست"، و"برسبكتيف"، للتعبير عن "التأثيرية"، و"السريالية"، و"السريالي"، و"المنظور الهندسي".
والآن، لم يبقَ إلا إيراد النَصّ بتمامِه، تحت العنوان والتعليق التمهيدي اللذَين نُشِر أسفلهما في الكتاب:
"الفن في مصر"
حديث لحضرة صاحب العزة "محمود سعيد" بك.
ضم مجلسُ أدبٍ جماعةً من هواة الفن وحَمَلة القلم، وكان بينهم الفنان الكبير الأستاذ "محمود سعيد" بك، فاستدرجه حديثُ المجلس إلى الإدلاء بآراءٍ ونظرياتٍ هذه خلاصتُها:
"ليس من السهل التحدث عن فن مصري حديث، كما يُتَحَدَّث مثلاً عن الفن المصري القديم، أو الفن الإغريقي القديم، أو الروماني، أو العربي، أو الزنجي، أو غير ذلك من الفنون التي ترمز صفتُها الإقليمية إلى خصائصها ومميزاتها، بل ليس من السهل التحدث عن الفن الحديث في أي بلدٍ بعَينِه، كفَنٍّ له شخصية مستقلة بين فنون سائر البلدان. فإن الحديث عن الفن عموماً متأثر إلى حد بعيد بدراسات الفنون القديمة والنظريات المستحدَثة في التعبير بالنحت والتصوير.
والواقع أن الفن عموماً، لا وطن له، وهو لا يعرف حدوداً ولا قيود، ومن العبث محاولة حَصرِه في أصول محدودة أو قياسه بمعايير خاصة.
وكل ما ظهر من مدارس أو مذاهب في الفن لم يُقَيّد الفنَ نفسَه، وإنما كانت هذه أوصاف لأساليب مختلفة في التعبير الفني. والفن لا يُنسَب إلا إلى الفطرة. وقد كان يمكن أن يقال هذا فن فارسي أو فن إغريقي أو فن فرعوني، عندما كان كل جنس من تلك الأجناس مرادفاً لفطرة مختلفة عن فطرة غيره. أما الآن فمن الصعب جداً أن يقال هذا فن إيطالي أو فن إنجليزي أو فن فرنسي أو فن تركي، لأن الفطرة الفنية في مختلف الشعوب العصرية، قد تأثرت كثيراً بالتفاعلات الاجتماعية المختلفة والتطورات المعيشية التي أصابت مدنيةَ كل شعب، حتى ليبدو أن العالم كله يتجه الآن نحو مدنية موحدة، وأصبحت المدنية عالمية تُنسَب إلى الزمن لا إلى شعبٍ بعَينِه من الشعوب.
ومِن شواهد ذلك أن أحدث المدارس الفنية، تتجه الآن نحو نهج الفطرة الأولى، فهي تعود إلى الفن الزنجي أو الفن الفارسي، أو فن الأطفال الذي يمكن اعتباره أغنى وأنقى ينبوع للفطرة، ومحاولة التجرد من المؤثرات العقلية الحديثة، التي لا تخلو منها الدراسات الأكاديمية الشاملة لمختلف المناهج والأساليب.
وليس الفن عِلماً يُلَقَّنُ في المدارس والمعاهد، فيُخَرِّجَ فنانين، وإنما هناك فقط، إلى جانب تاريخ الفن ومذاهبه، وأساليبه المختلفة، (استيتيك) أصول وقواعد لما يُسَمّى صنعة الفن (التكنيلوجيا) وهي تتناول أدوات الفن، مثل تركيب الألوان والزيوت والورنيش، ومعرفة تفاعلها ودرجة بقائها وصلاحيتها، واختيار وتحضير التيل أو الخشب، وتركيب الطينة، وانتقاء نوع الجرانيت والحجر والمرمر، وغير ذلك مما يتصل بالمواد الأولية. أما الفن نفسه فهو الإبداع والخلق والتنسيق.
ولا يتسع المجال هنا للاستطراد في الحديث عن الناحية العامة من الموضوع، فالموضوع هو الفن المصري.
والحديث عن الفن المصري، يكاد يكون حديثاً عن غير موضوع. فإن الفن المصري الحديث لا يزال في دور التكوين. أما إذا كان الغرض سرد بعض الوقائع المتعلقة بالفنون الجميلة في التاريخ المصري الحديث، فيمكن القول إن أول محاولة لبعث الاهتمام بالفنون في مصر بدأت في أوائل هذا القرن (سنة 1907) إذ قامت مدرسة الفنون التي أسسها الأمير يوسف كمال. وهذه المدرسة هي التي تخرج منها بعض الفنانين اللامعين، مثل مختار (في النحت) وعياد ويوسف كامل وصبري (في الرسم) ومحمد حسن (ولم يتخصص في فرع بعينه، بل عمل في النحت والرسم والزخرفة) وقد سارت هذه المدرسة على تقاليد "التأثيرية" (امبريسيونسم)، حتى بعد أن تحولت إلى مدرسة الفنون الجميلة. وكانت هذه التقاليد هي السائدة في أكثر مدارس الغرب.
ومنذ عهد قريب، أي منذ عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، قامت في مصر جماعة "السورياليست"، ومن أبرز رجالها رمسيس يونان والتلمساني. و"السورياليزم" يعني فوق الحقيقة أو ما وراء الملموس. وبعبارة أخرى هو رؤى العقل الباطن. ومن غير المعقول أن يعبر المرء وهو مكتمل الوعي والإدراك عن شيء غير مدرَك بالحواس. فمن المناظر ما يضع الناظر أمام شيء غامض يصعب التعبير عنه، والسورياليزم هو وجود هذا الشيء في اللوحة أو التمثال، ولا يستطيع إيجاده إلا فنان كبير. والفنان الكبير يبدع في تصوير لوحة أو نحت تمثال بتعبير غامض يسحر الناظر إليه، دون أن يتعمد ذلك. فإن كيريكو الذي يُعَدُّ أبا "السورياليزم" لم يكن يخطر بباله أنه ينشئ مدرسة جديدة أو مذهباً جديداً هذا اسمه عندما رسم مناظره الإيطالية الأولى. ولا شك أن رمبرانت وجريكو وجيوفاني بليني في بعض إخراجهم خلقوا السورياليزم ولكن دون أن يقصدوا ذلك.
ومن "المستقلين" في مصر ناجي مدير معهد روما، وحامد سعيد، وراتب، والجباخنجي، وحامد عبد الله، وصلاح الدين طاهر، وسيف الدين وانلي، وأدهم وانلي، وكامل الديب، ومرجريت نخلة، وصدر، وحسين حاتم، والأستاذ عفيفي، وسعد الخادم من معهد التربية العالي، والأستاذ حبيب جورجي. ومما هو جدير بالذكر أن عفيفي وحبيب جورجي كان لهما تأثير كبير في أسلوب تعليم النشء أصول الفن. وقد بدا أثر هذا الأسلوب بوجه خاص في المدارس الأولية. وهذا الأسلوب يقوم على مبدأ ترك الطفل مطلق الحرية ليرسم ما يهواه وما يوحيه إليه خياله، والاقتصار على مساعدته وتوجيهه.
وقد كانت لحبيب جورجي (وهو رسام) تجربة عظيمة الشأن في النحت. إذ جمع 43 صبياً وصبية، وحضّر لهم الطينة، وطلب منهم أن يعمل كلٌّ منهم التمثال الذي يتخيله أو يريده، بعيداً عن المؤثرات الخارجية، وبعيداً عن الزُخرُف والوَشي. والأستاذ جورجي يعتقد أن فن النحت كامن في الشعب المصري، وقليل من الجهد والرعاية قَمينٌ بأن يكشفه ويبرزه.
ويبدو أن هذه التجارب، وما كشفت عنه من فن فطري في الطفل المصري، هي بداية الفن "المصري" الحقيقي. فإن أكثر الفنانين الآخرين متأثرون بدراساتهم للفنون الغربية أو الأكاديمية، في حين أن هؤلاء يعبرون بطريقة فطرية مصرية صميمة.
وفي هذا عودة إلى فن الفطرة، فن العبيد أو الفن الفارسي البعيد عن التصوير الفوتوغرافي، والذي لا يتقيد بِنِسَب الأحجام والمسافات "برسبكتيف". والواقع أن هناك من مشاهير الفنانين العالميين مَن رجعوا إلى الفن الفطري، مثل ماتيس الذي تشَبَّع بالفن الفارسي، وبيكاسو الذي استوحى الشيء الكثير من فن العبيد والفن الإفريقي.
بَيدَ أن الفن، مثل الشعر والأدب، تتوقف قيمته في أي بلد على شخصية الفنان الذي ينتجه هذا البلد. وإن ما نحتاج إليه في مصر شخصيات عبقرية بارزة، أو "أساتذة" في الفن، لا معلمون.
وإن لدينا عدداً من النحاتين المرموقين، خلاف المصورين السابق ذكرهم، مثل أحمد عثمان، ورزق، والسيد مرسي صادق، ومحمود موسى، وفتحي محمود، وفرج منصور، الذين تمموا رسالة مختار، هذا العبقري العصامي الذي أحيا من جديد الفن الفرعوني بعد ركوده آلاف السنين، وفي اللحظة التاريخية التي بدأ فيها هذا الفن الخالد يتألق من جديد، بجماله ورهبته وروعته وحيويته، في جميع الأوساط الفنية العالمية. وهناك من النزلاء الأجانب في الإسكندرية لفيف من الفنانين، أصبحوا بحكم البيئة "إسكندريين"، أي أنهم لا يُعَدّون من الناحية الفنية إيطاليين أو يونانيين أو فرنسيين أو سوريين أو لبنانيين؛ فقد بعُدَت الصلة بينهم وبين أوطانهم الأولى، ومن هؤلاء زانييري، وآنجلوبولو، وباباجورج، وباروخ، وسباستي، وساليناس، وبادارو، وسكاليت، وجبي، وكريمزي، وجرمين شلهوب.
وبعد، فإن الفنون الجميلة لا تزدهر إلا في أحوال الاستقرار والرخاء. وقد كانت الأحوال في مصر في الحقبة الأخيرة بعيدة عن الاستقرار، فلم يكن هناك مجال ملائم للفن، إذ كانت الأفكار منصرفة للمشاغل السياسية والعيش. وكل ما يُرجَى أن تكون بواكير النهضة المصرية الحديثة فاتحة نهضة زاهرة، في العلوم والفنون أيضاً. ولابد لأمة ناهضة من فن يعبر عن خلجاتها وروائع الفطرة الكامنة فيها". (انتهى).


















